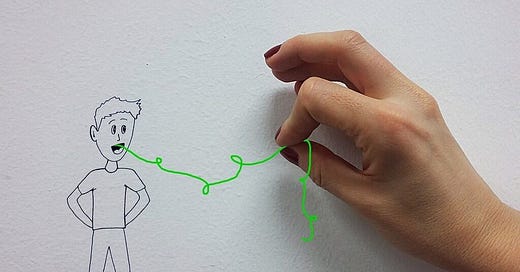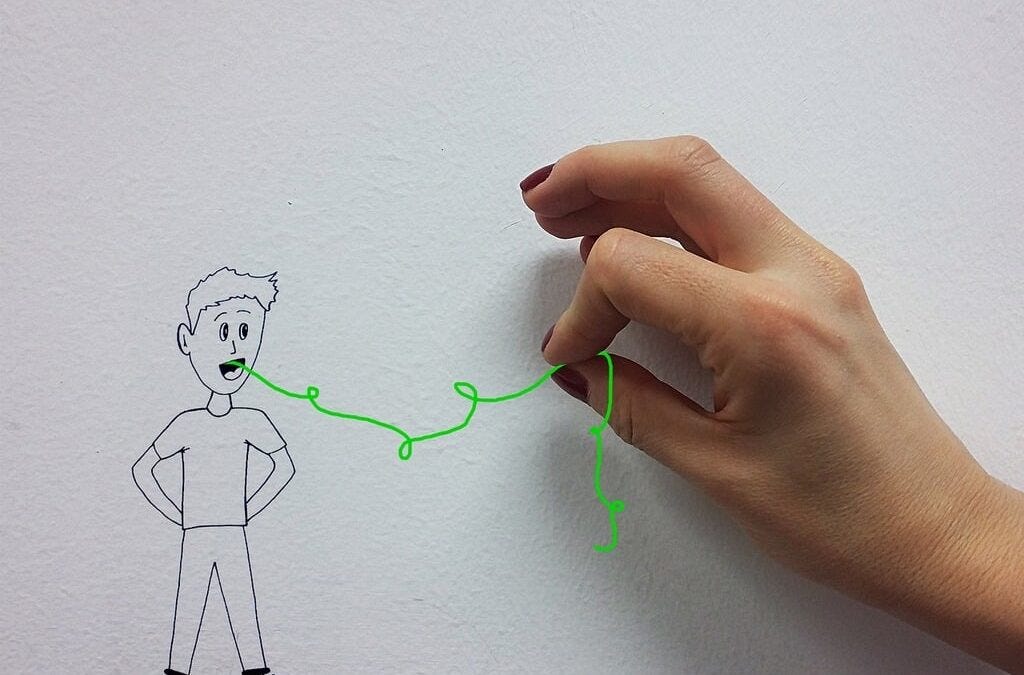الرد على مقال فعالية العلاج النفسي : بين العلم و الإدعاء
وجهة نظر نقدية للمقال بقلم الدكتور خليل فاضل
مقدمة
قد تكون المقالات الأكاديمية والمترجمة – خصوصًا حين تتناول قضايا بالغة التعقيد كفعالية العلاج النفسي – نافذة للتأمل، ولكنها في الوقت ذاته تفتح أبوابًا واسعةً للحوار، خاصة حين تتقاطع مع خبرات طويلة ومباشرة في ميدان الممارسة.
انطلقت شرارة هذا النص من مقال طويل مُترجم عن منصة "Aeon"، تناول فيه كاتبه فكرة أن صدمات الطفولة لم تعد حجر الأساس في فهم المعاناة النفسية، بل ذهب إلى القول بأن العودة المستمرة إلى الماضي قد تكون ضارة أحيانًا. لم يكن هذا الطرح مجرد رأي عابر، بل خلاصة توجّه بدأ يجد له صدى في أوساط نفسية معينة في الغرب. لكنه – بطبيعة الحال – أثار نقاشًا حيًّا لدى من خبروا الألم النفسي في عمقه، لا بوصفه ظاهرة، بل كتجربة إنسانية متكررة.
وكان من بين هؤلاء الدكتور خليل فاضل، الطبيب النفسي المعروف، الذي كتب ردًا مطولًا على المقال على بريدي الإلكتروني، لا ليجادل، بل ليفكك الفكرة من قلب الممارسة، ومن ذاكرة مهنية عريقة تمتد لأكثر من نصف قرن من العمل العيادي مع المرضى. وجاء رده هذا صريحًا، مفعمًا بالتجربة، ومليئًا بذلك الحس الإنساني الذي قلّما نجده في الكتابات الأكاديمية.
وقد كان لي، بوصفي قارئًا ومؤسسًا لمدونة "قراءات كانوية"، أن أتفاعل مع هذا الرد، لا من موقع الجدل، بل من موقع الامتنان، ومن رغبة في إضاءة بعض الأسئلة التي أثارتها المقالة الأصلية، على ضوء ما تفضل به الدكتور من تأملات.
وما لبث هذا التبادل أن اتخذ شكلًا إنسانيًا وفكريًا راقيًا، تميّز بتواضع في الطرح، وسمو في الخطاب، حتى صار هذا النص المشترك شهادة على إمكانية الحوار العابر للتخصصات، والذي لا يسعى لحسم القضايا، بقدر ما يسعى لإغنائها.
نترككم الآن مع نص الدكتور خليل فاضل، ثم تعقيبي عليه، فعودة منه تُكمل الحوار برقيّ العالم ومحبّة الإنسان.
د. خليل فاضل يعلّق على المقال:
فعالية العلاج النفسي بين الإنكار الغربي المتأخر وتجاربنا الحيّة
قرأت المقال المطوّل المترجم عن "أيون" بعين نقدية وبقلب ممارس إكلينيكي، فأثار فيّ مشاعر مختلطة من الدهشة، والأسى، والضحك المكتوم. ليس لأنه يخلو من الفكر أو العمق، بل لأنه – وببساطة – يعبّر عن إنكار غربي متأخر لما عرفناه نحن قديماً وحديثاً: أن الحاضر ليس وليد لحظته، بل هو ابنٌ شرعي لماضٍ لم يُحلّل.
يظن كاتب المقال – وقد أتى من خلفية علمية بريطانية – أن فرضية الطفولة كمصدر للمعاناة النفسية قد عفا عليها الزمن، وأن دراسات التوائم ونتائج الوراثة السلوكية قد نقضت ما جاء به فرويد، بل ونسفت أهمية البيئة الأسرية. ويقفز إلى نتيجة جريئة: أن الحديث عن صدمات الطفولة وتحليلها لم يعد ذا جدوى، بل قد يكون ضارًا.
لكنني، خلال نصف قرن من العمل السريري العيادي، رأيت بعيني – ولم أقرأ فقط – كيف أن جراح الطفولة هي الجرح المؤسس لكثير من اضطرابات القلق والاكتئاب واضطراب الشخصية الحدية والوسواس القهري ونوبات الهلع وحتى الذهان أحيانًا. وكل الحالات التي شُفيت أو خفّت وعادت إلى الحياة، كان لا بد لها أن تمر من ممر الطفولة: أن تسترجع، وتفهم، وتبوح، وتبكي، ثم تعيد ترتيب المعنى.
نحن لا نقدّس الطفولة، بل نفككها.
الطفولة ليست سجنًا أبديًا، ولكنها بوابة ضرورية. ومن دون الدخول فيها، تبقى الأعراض تتكرر وتتجدد بأقنعة شتى.
علم النفس ليس رياضيات. لا تُقاس المعاناة فقط بدراسات إحصائية على التوائم، ولا بالجينات التي لها ألف قيد وسياق. بل إن الإنسان، ككائن رمزي، يعيش داخل المعنى قبل أن يعيش في الحمض النووي.
فكيف نختزل كل هذا الغنى في مجرد "تطبيع" للمعاناة، أو أن نرمي بعمق النظرية الدينامية بحجة أن الغرب تعب منها؟
ثم يتحدث الكاتب عن علاقة المعالج بالمريض كما لو أنها شبه تجارية، تشبه مهنًا مشينة، وينسى أن مئات الآلاف وجدوا في الجلسة الآمنة ذلك الحضن الرمزي الذي لم يجدوه في بيتهم.
العلاج ليس استهلاكًا، بل كشفٌ وبناءٌ وتحوّل.
أما وصفه للعلاج النفسي للأطفال بأنه قد يضر أكثر مما ينفع، فهو تبسيط فجّ لتجربة شديدة التعقيد. نعم، قد نفشل أحيانًا، لكن ذلك لا يبرر نسف النموذج بأكمله.
والأنكى من ذلك، هو تلميحه إلى أن الثقافات الأخرى (كسريلانكا) نجحت لأنها لم تهتم بالصدمة! وكأن آلام الناس تختفي حين لا نسمّيها، وكأن الكتمان شفاء.
الخلاصة؟ أنا لا أقول إن كل ما في مدارس التحليل النفسي صائب، ولا أن العلاج بالحديث يكفي دائمًا. ولكنني أقول بيقين الإنسان الذي عايش المرضى وآلامهم، إن الطفولة إذا لم تُحلّل، تظل تهمس في أذن البالغ: "أنا هنا... لا تنسَني".
والمعالج، حين يساعد مريضه على سماع هذا الهمس، لا يمارس شعوذة ولا خرافة. بل يمارس أصدق ما في الإنسانية: الإصغاء لجذر الألم، لا لقشرته.
ذلك هو العلاج. وتلك هي فعاليته.
— د. خليل فاضل
ردي على وجهة نظر الدكتور النقدية
لقد قرأت ردكم الكريم على المقالة بعين ممتنة، وبقلب يقدّر الجهد الذي بذلتموه في قراءتها وتأملها، ثم في صياغة هذا النقد العميق الذي يعكس خبرة طويلة وتجربة ثرية في ميدان العلاج النفسي.
أقدّر تعليقكم وتفكيككم لبعض الأفكار التي وردت في المقالة. وأما بعض النقاط التي أشرتم إليها، فإني أود أن أقف عندها قليلًا، لا من باب المجادلة، بل من باب الحوار الذي يثري الفكرة، ويعمّق النظر في الأمور.
فأنتم تقولون إن جراح الطفولة هي الجرح المؤسس لكثير من الاضطرابات، وإن المرور بممر الطفولة ضرورة لا محيد عنها في طريق العلاج. وأنا لا أملك أن أخالف هذا الرأي، فقد أثبتته التجربة، وشهدت به شواهد لا تحصى. ولكني أسأل: أليس من الممكن أن يكون بعض المرضى قادرين على تجاوز هذه الجراح بغير تحليل، أو على الأقل بغير تحليل مطوّل؟ أليس من المحتمل أن تكون بعض العقول – بفطرتها أو بتجاربها – قادرة على التكيف والمضي، بغير أن تعود إلى النبش في الماضي؟
ثم إنكم تشددون على أن الإنسان كائن رمزي، وأن المعنى هو الذي يشكّل وجوده، قبل أن تصوغه الجينات أو الدراسات الإحصائية. وأنا معكم في ذلك، بل أراه حجر الأساس في فهم النفس البشرية. ولكن، ألا يمكن أن نقول إن التفاعل بين المعنى والبيولوجيا أكثر تعقيدًا مما تصوره مدارس التحليل النفسي الكلاسيكية؟ ألا يكون للوراثة نصيبها، لا من باب الحتمية، بل من باب التفاعل الذي لا يُختزل في معادلة واحدة؟
أما ما ذكرتموه عن أن المقالة تلمّح إلى أن الثقافات الأخرى نجحت لأنها لم تهتم بالصدمة، فأخشى أن يكون هذا التأويل أوسع من قصد المقالة ذاته. فلم يكن الغرض إنكار الألم، ولا الادعاء بأن الكتمان علاج، ولكن كان الغرض – أو هكذا فهمتُ – طرح تساؤل حول ما إذا كانت بعض الأساليب العلاجية قد تُضخّم المعاناة حين تسلط عليها الضوء، بدلاً من أن تساعد على تجاوزها. وهو سؤال قد يكون جوابه بالنفي، ولكنه يظل سؤالًا يستحق التأمل.
رد الدكتور الفاضل
أخي العزيز، تحية من القلب وبعد،
قرأت ردك الكريم بعين مفعمة بالامتنان، ووجدتُ فيه ما يُنعش النفس ويُسرّ القلب:
بالنسبة لما تفضلت بطرحه من تساؤلات، فهي في رأيي ليست اعتراضات، بل دعوات للتفكير من زوايا متعددة، وهذا ما نحتاج إليه دائمًا، لا سيما في مجال تتداخل فيه الذات بالتجربة مثل العلاج النفسي.
وأما سؤالك عن إمكانية تجاوز بعض جراح الطفولة دون تحليل مطول، فأقول: نعم، يحدث هذا، لا سيما عند من يملكون بنية نفسية مرنة، أو دعائم داخلية قوية، أو حتى شبكة علاقات شافية وسأكون صريحا في أول تفاعل بيننا وأقول أنا أحد هؤلاء.
لكني ما زلت أظن أن المرور – ولو الرمزي – عبر أروقة الطفولة، ضروري في كثير من الحالات، لا لاستدعاء الألم من أجل الألم، بل لفهم كيف تكوّن الشعور بالعجز أو الذنب أو النقص، ثم تحرير الإنسان منه.
أما التفاعل بين المعنى والبيولوجيا، فأتفق تمامًا معك في أنه أكثر تعقيدًا من أن نختزله في معادلة أو مدرسة. بل أزعم أن كل محاولة لفصل الجسد عن المعنى، أو العكس، تظل قاصرة عن فهم الإنسان في شموله.
وفيما يخص المقالة، فلم أفهمها أبدًا على أنها تُنكر الألم، ولا أن فيها دعوة للكتمان، بل قدّرت فيها تلك اللمسة التأملية التي تطرح سؤالًا مهمًا: هل يساعدنا التركيز المفرط على الألم أم يُثقِلنا؟
سؤال مهم، حتى لو اختلفنا في الإجابة.
وأود أن أضيف – من واقع خبرتي الطويلة – أن المرور عبر جراح الطفولة لا يكون شافيًا إلا إذا تم بأيدٍ متمرسة، تملك الحسّ الإنساني، والموهبة الإكلينيكية، والدفء الضروري في التعامل مع الكائن المجروح.
فالتعامل مع الصدمة على يد من يفتقرون إلى الخبرة أو المهارة – أو حتى الحدس العلاجي – قد لا يساعد المريض على التضميد، بل قد يعيد فتح الجرح، بل وتعميقه أحيانًا.
بعضهم – دون قصد – يجعل المريض أسيرًا للصدمة، لا محررًا منها، لأنه يُفتن بالدور العلاجي أكثر مما يُصغي لاحتياجات الإنسان أمامه.
مع مودتي وتقديري،
خليل فاضل
ختام
في خضم هذا الحوار، تتبدى حقيقة أساسية: أن الطب النفسي ليس معادلة جافة، ولا وصفة صلبة، بل هو مسار بشري، تتقاطع فيه البيولوجيا بالمعنى، والذاكرة بالمستقبل، واللغة بالجسد. ومن هنا، فإن كل رأي أو تأمل، سواء جاء من داخل العيادة أو من خلف طاولة القارئ، إنما هو لبنة في بناء فهم أوسع، لا يهدف إلى الإقناع، بل إلى الإنصات.
إن ما أثمره هذا التفاعل مع الدكتور خليل فاضل ليس مجرد جدل حول فكرة، بل هو تذكير بأهمية الإصغاء لجذور الألم، وبأن الإنسان لا يُفهم إلا حين ننظر إلى تاريخه النفسي بوصفه سردية تستحق التفكيك، لا الإهمال.
ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور خليل فاضل ليس فقط طبيبًا ممارسًا وصاحب تجربة ممتدة، بل هو أيضًا كاتب أسبوعي في صفحة الرأي بجريدة المصري اليوم كل يوم جمعة، حيث يطل على قرائه من نافذة التأمل والتحليل الإنساني. كما صدرت له مجموعة من الكتب البارزة، من أهمها:
"سيكولوجية الإرهاب السياسي" و"البوح العظيم: المصريون وما جرى لهم وبهم من 2011 إلى 2015"، وهي أعمال تجمع بين الحس السوسيولوجي والفهم العيادي العميق.
وقد انتهى مؤخرًا من تأليف كتاب جديد بعنوان "السيكودراما: فن الفرجة وعلاج الصرخة"، ويعمل حاليًا على رواية يرى فيها – ومعه من قرأ فصولها الأولى – مشروعًا أدبيًا مختلفًا عما يُطرح في الأدب العربي المعاصر.
وأحسب أن هذه التبادلات بين المقال والتعليق والرد، ما هي إلا صورة لما نأمل أن تكون عليه نقاشاتنا: متأنية، صادقة، وجامعة بين العقل والقلب.
للقراء الكرام: مرحبًا بتعليقاتكم، وبتجاربكم، وبأسئلتكم. فالحوار لا يكتمل إلا بكم.