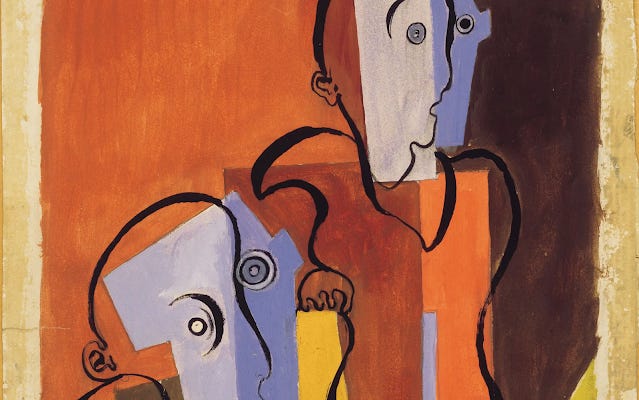فعالية العلاج النفسي : بين العلم و الإدعاء
نقد لممارسات العلاج النفسي الديناميكي، والتساؤل عن مدى استنادها إلى أسس علمية أو كونها مجرد ادعاءات
ما الوجود إلا حركة مستمرة بين الإنسان والآخر، وما الحياة إلا حوار يتردد صداه منذ أقدم العصور، إذ لم يزل الناس يتحدثون عن أنفسهم، عن قضاياهم، عن آلامهم وأحلامهم، طامحين إلى أن يجدوا في هذا الحديث عزاءً لأنفسهم، أو كشفًا لمعنى يبدد حيرتهم، أو بهجة تنير لهم عتمة الأيام. وكان فيهم من عُرف بالحكمة، وفيهم من سُمّي بالشامان، وفيهم من لُقب بالكاهن، ثم أتى زمان صار هؤلاء يُعرفون بالمعالجين النفسيين. فلما جاء سيغموند فرويد، حاول أن ينقل هذا الفن من عالم الممارسة والتجربة إلى ميدان العلم، وأن يجعل منه فرعًا من فروع المعرفة، وأطلق عليه اسم "العلاج النفسي".
بيد أن العلم فيه قليل، إن لم يكن منعدمًا.
فالوجود للآخر ليس أمرًا هينًا، بل هو من أشق ما يُطلب من الإنسان، إذ لا استقرار فيه ولا طمأنينة، لأن هذا الآخر متبدل، لا يثبت على حال، بل تتغير أحواله وأفكاره كما تتغير الأيام. ولكن في هذا التبدل سر الفن ذاته. فمن أراد أن يجيده، لم يكن له بد من أن يتحلى بالخبرة، وأن يتسلح بالذكاء، وأن يستضيء بالحكمة، وأن ينهل من المعرفة. وليس هذا مما يُكتسب في يوم أو يومين، أو يُحصَّل في درس أو درسين، بل هو شيء لا يتأتى إلا بعد أن يرى الإنسان آلاف الوجوه، ويسمع آلاف القصص، ويقرأ مئات الكتب في الفلسفة والأدب والعلم، ولا بأس أن يضيف إليها بعض الروايات العاطفية التي لا تُعد في العرف الجاد من ضروب المعرفة. ولا يكمل هذا الفن إلا إذا كان الممارس قد جرب المهن المختلفة، وعرف شيئًا من مذاهب السياسة، وربما دخل في دين، ثم خرج منه، ثم عاد إليه، أو انتقل إلى غيره، إذ كيف له أن يفهم ما يكون من شوق الإنسان إلى الله، أو ما يعتريه من حيرة في البحث عنه، أو ما يملأ قلبه من فرح حين يهتدي إليه، أو ما يسحق روحه من ضياع حين يفتقده، إذا لم يكن قد ذاق ذلك كله بنفسه؟
وقد كان هذا هو دافعي إلى دخول هذا المجال، فاخترت أن أكون معالجًا نفسيًا، بل وعالمًا نفسيًا، إذ بدا لي أن الخير كل الخير في أن أساعد الناس، وأن أعينهم على اقتلاع جذور المعاناة من نفوسهم. ثم بدا لي أن الطفولة هي المنبع الذي تتدفق منه هذه المعاناة، فاتجهت إلى العلاج النفسي للأطفال، آملًا أن أصل إلى مصدر الألم قبل أن يستفحل. وخضت في عالم الشعور، محاولًا أن أفهم كيف يمكن للإنسان أن يتطهر من آلامه إذا غاص فيها بوعي كامل. ودرست الصدمات النفسية، حتى قبل الولادة، وكتبت فيها رسالة للدكتوراه. فلما مضى على هذا المشوار عقدان، صرت أمارس العلاج، وألقي المحاضرات، وأشرف على الطلاب، وأكتب في كل ما يتعلق بهذه الأمور. لكنني، بدلًا من أن أزداد يقينًا بما تعلمته، صرت أنفر منه، وأرفض كثيرًا مما لقنته في سنوات الدراسة والتدريب.
عدت إذن إلى حيث بدأت، إلى فن "الوجود من أجل الآخر"، وهو مفهوم لم أبتكره وحدي، بل تبلور عبر حواراتي مع زميلتي صوفي دي فيوكسبونت. وصرت أرى نفسي أقرب إلى المرشد منه إلى المعالج، وإلى الصديق منه إلى الأستاذ، وإلى الصدى الذي يعكس الصوت، أكثر مما أرى نفسي صوتًا منفصلًا مستقلًا. وما عملي إلا أن أرافق الناس في رحلتهم عبر تعقيدات الحياة وعبثها وأفراحها وآلامها.
ولكن هذه الرحلة الطويلة، على ما فيها من دروس وخبرات، جعلتني أفقد شيئًا من إيماني القديم. فلم أعد أرى أن الوعي وحده كافٍ ليكون علاجًا، ولا أن فهم صدمات الطفولة هو مفتاح التحرر من كل ما يعانيه الإنسان، ولا أن المشاعر، متى واجهها الإنسان بصدق، تزول من تلقاء نفسها، كما كنت أعتقد يومًا. بل رأيت أن الأمر أعقد من ذلك، وأن ما يقال في قاعات الدرس شيء، وما يحدث في واقع الحياة شيء آخر.
وكان هذا التحول في تفكيري قد بدأ حين رجعت إلى اهتمام قديم بعلم الأحياء التطوري، ووقعت بين يديّ كتب تُناقش دراسات التوائم، وأهمها كتاب "Blueprint" (2018) لروبرت بلومين، الذي اعتمد على عقود من الأبحاث حول التوائم في دول مختلفة، وكانت نتائجه صادمة: لم يكن للطفولة ولا لتربية الوالدين ذلك التأثير الحاسم الذي كنا نظنه في تحديد هوية الإنسان ومستقبله.
ثم عدت إلى كتاب آخر، هو "No Two Alike" (2006) لجوديث ريتش هاريس، فوجدت فيه امتدادًا للفكرة ذاتها، إذ عرضت المؤلفة دراسات واسعة تناولت ليس التوائم فحسب، بل أنواعًا أخرى من الكائنات. وخلصت إلى أن الدماغ ليس لوحًا فارغًا تُكتب عليه التجربة كما يُكتب الحبر على الورق، بل هو أشبه بصندوق أدوات طوّره الانتخاب الطبيعي ليمنح كل إنسان مجموعة من المهارات التي تجعل منه كائنًا فريدًا، لا يشبه غيره تمامًا.
وقد لخص علماء الوراثة السلوكية هذا كله في عبارة موجزة، هي "القانون الثاني لعلم الوراثة السلوكي"، ومفادها أن تأثير الجينات على السلوك البشري يفوق تأثير البيئة الأسرية. وحين قرأت هذا، شعرت أنني في مأزق، إذ وجدت نفسي أبحث عن أي ثغرة في هذا العلم تهدم ما توصل إليه. ولكن الحقيقة لم تكن تقبل التأويل: التوائم المتماثلة، الذين نشأوا في بيئات مختلفة، كانت شخصياتهم متشابهة جدًا، بينما الإخوة بالتبني، الذين نشأوا في البيت ذاته، لم تكن بينهم هذه الدرجة من التشابه.
ذلك كشف من شأنه أن يهز أركان ما ترسّخ في أذهان أهل العلم والنظرية، فقد نُشر في مجلة "علم النفس التنموي"، وأثار من الجدل ما يليق بما ينقض المُسلّمات ويزلزل اليقين. إذ جاء بما لا يطيقه أصحاب المدرسة الديناميكية النفسية، وجعل سنوات من التعلم والتدريب في مهب الريح. كيف لا، وهو يقرر أن البيئة الأسرية، التي طالما قيل إنها حجر الأساس في تكوين الشخصية، ليست ذات شأن يُذكر! سواء نشأ الإنسان بين والدين يفيض منهما الحنان، أو بين أبوين جافين لا يكاد الدفء يجد إلى قلبيهما سبيلًا، سواء عاش في بيت تغمره النعمة، أو في دار يقتات أهلها بالكفاف، فإن شخصيته تمضي في مسارها الذي لا يحيد، وكأن هذه العوامل لا أثر لها ولا سلطان. وإن كنت قد تلقيت تدريبًا في العلاج النفسي، فإن هذا القول ينقض كل ما عرفت، ويفسد كل ما تعلمت.
لكن العجيب أن هذا الزعم الجديد، على صدمته، لم يكن غريبًا على ما شهدته في تجاربي مع عملائي، ولا بعيدًا عما عشته في حياتي. ذلك أن مبادئ العلاج النفسي لم تكن يومًا تعكس حقائق الواقع، بل كانت تعكس ما نريد أن نراه، وما نبحث عنه في ضوء مشاعرنا الحاضرة. إن المرء إذا أحزنه يومه، عاد بذاكرته إلى طفولة لم يرَ فيها إلا الحرمان والشقاء، وإذا أشرق في نفسه السرور، تراءت له تلك الأيام وكأنها كانت كلها فرحًا وهناء. ولعل خير شاهد على ذلك ما نجده في كتب السير الذاتية، مثل الجري بالمقص (2002)، وكن مختلفًا (2011)، والرحلة الطويلة إلى المنزل (2011)، حيث تجد تصويرًا لعائلة واحدة، ولكنه يختلف اختلافًا يكاد يجعلك تظن أنك أمام ثلاث عائلات لا صلة بينها.
وقد تأكد هذا كله حين طُبّقت الدراسات الطولية القليلة التي تتبعت الأطفال من أعوامهم الأولى حتى بلغوا مبلغ الرجال والنساء، لتبحث في أثر التجارب السلبية في الطفولة، أو ما يُعرف بـ ACEs، على صحتهم النفسية حين يكبرون. لكن المفاجأة أن هذه الدراسات لم تجد رابطًا بين تلك التجارب والصحة العقلية السيئة في الكبر. لم يكن الرابط إلا بين ما يعانيه الإنسان في حياته الراهنة وبين استرجاعه لما مر به في صباه. قد يبدو هذا القول عجيبًا، بل مناقضًا لكل ما اعتقده أهل العلم في مهنة جعلت من نظرية الصدمات محورًا لأفكارها، لكنه قول تؤيده الأرقام، ولا سبيل إلى إنكاره.
إننا لم نثبت بعد أن هذه التجارب الصعبة في الطفولة هي التي تسبب الأمراض النفسية، ولكننا حين نقاسي الألم في كبرنا، نميل إلى تأويل طفولتنا على أنها كانت بائسة، وكأننا نبحث في الماضي عن تبرير لما نعانيه في الحاضر. ولست أزعم أن هذا يسري على كل الأحوال، فلا ريب أن هناك استثناءات نادرة، حيث تترك التجارب المروعة أثرًا لا يُمحى، لكنني كلما تفكرت في الأمر، وجدت يقيني يتزعزع، إذ كيف نفسر أن حدثًا واحدًا قد يصدع قلب طفل، بينما يمر به آخر فلا يترك في نفسه أثرًا يُذكر؟
فإذا كنت ممن يرفضون هذا الرأي قبل أن يتدبروا حججه، فقد تكون تفعل ما يفعله المتعصبون في الدين منذ أقدم العصور. قد تراه قولًا جافيًا، أو حكمًا قاسيًا، أو زعمًا لا يوافق هوى الناس، لكن المشاعر لا ينبغي أن تكون دليلًا يُحتج به في ميدان البحث والمعرفة.
بل الأجدر أن تتريث، وأن تنظر في الأمر نظرة من لا يخشى الحقيقة. فليس في هذا ما يُنافي التعاطف مع آلام البشر، ولا ما يُنكر ضرورة البحث عن سبل لمساعدتهم، وإنما هو إعادة نظر في أسباب معاناتهم، علّنا نهتدي إلى سبل أكثر نفعًا في معالجتها. فلعل ما تعلمناه في العلاج النفسي لم يكن سوى بناء هش، يقوم على تفسير خاطئ لمعاناة الإنسان. ولو نظرنا إلى الأمم المختلفة، لوجدنا أن لكل منها رؤيتها الخاصة في فهم الألم والتعامل معه، ومع ذلك لا يقل اهتمامها بتخفيف معاناة أفرادها عن اهتمامنا.
فنحن بحاجة إلى أن نعيد النظر، وأن نتأمل هذه الأسئلة بعين الباحث المتجرد. لقد قال فرويد، وقال أنصاره، وقال جابور ماتي إن معاناتنا تنبع من طفولتنا، وإن شخصياتنا ليست سوى انعكاس لما مر بنا في تلك السنوات الأولى. وهذا قول قد يطرق القلوب فيجد فيها صدى، لكنه قد يكون – مع ذلك كله – خطأً. وإن كان خطأً، فقد تكون علاجاتنا كلها ضربًا من العبث، لا تجدي، بل ربما تزيد الطين بلة. فلا مفر لنا، إذن، من أن نعيد فحص هذه النظريات، وأن نقف منها موقف النقد الصارم، لئلا ننخدع بما ألفناه، فنكون، من حيث أردنا الخير، سببًا في مزيد من الأذى.
لقد مضت الأمم، منذ أقدم العصور، تنظر إلى الطفولة على أنها مرحلة من مراحل الحياة، لا تزيد عنها ولا تنقص، ولا تضفي عليها من القداسة شيئًا. ففي نيجيريا كما في ماليزيا، وفي الغرب قبل أكثر من خمسين عامًا، لم تكن الطفولة تُعطى هذا الشأن الذي يعزو إليها أهل اليوم. فالناس يتعلمون ويكتسبون المعرفة على مدى أعمارهم، غير أن المعاناة، حين تقع، لا تنشأ من ذكريات الطفولة، وإنما تنبع مما يعيشه المرء الآن، من علاقته بالعالم في هذه اللحظة، ومن ظروفه الحاضرة التي تحيط به وتؤثر فيه.
ولكن، أي غرور هذا الذي يحمل أهل الغرب على أن يفرضوا نظرية وليدة، لم تثبت بعد، فيجعلوها حقيقة عالمية غير قابلة للنقاش؟ كيف يستسلم المعالج النفسي الديناميكي، حين يجلس إلى عميله الذي يئن من الألم، لفكرة أن الحل يكمن في العودة إلى الماضي، بينما تخبرنا تقاليد الفلسفة في كل بقاع الأرض أن الإجابة ليست في الأمس، بل في اليوم؟ إن بوذا، كما لاو تزو، كما أرسطو، كما يسوع، لم يتحدثوا قط عن أثر لا يُمحى للطفولة في طبيعة الإنسان. لقد رأوا في البشر أفرادًا يُعرَفون بأفعالهم في الحاضر، لا بآثار بعيدة المدى لما مروا به في الصغر. وبعد قرون، كان الغزالي وتوما الأكويني يوجهان أنظارهما إلى الحاضر، يتأملانه ويبحثان فيه عن مواضع الخير والشر، ولم يكن للطفولة من حديثهما نصيب. بل حتى في القرنين الماضيين، لم يجد هيجل، ولا كيركغور، ولا وليم جيمس ضرورة للعودة إلى الطفولة لفهم الإنسان، وكأنهم جميعًا قد أجمعوا على أن المرء يُدرك بحاضره لا بماضيه.
فكيف يجوز لنا، ونحن في هذا العصر، أن نصرف النظر عن كل ذلك، لنسلم بنظرية لم تقدم بعد ما يكفي من الأدلة، ولم تثبت جدواها في واقع الحياة؟ لو كان العلاج النفسي الذي يدفع الناس فيه أموالًا طائلة قد أتى بالشفاء والراحة، لكان لنا أن نطمئن، ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. فاستطلاعات السعادة تُنبئنا بأن كثيرًا من النساء الغربيات – وهن الفئة الأكبر بين زبائن العلاج – لا يجدن في هذه العلاجات من النفع ما يُرضي، ولا من العزاء ما يخفف عنهن آلام الحياة.
ولقد كنت في البدء منكرًا لهذه الأفكار، نافضًا يدي منها، حتى وقعت على ما كتبته أبيغيل شريير في كتابها العلاج السيء (2024)، وهو الكتاب الذي أحدث ضجة، لأنه يكشف عن الأثر السام الذي تُحدثه ثقافة العلاج النفسي في المجتمع. وأخذت أسائل نفسي: أيمكن أن يكون عملي مع الأطفال – حيث ندور معهم في أروقة الماضي ونستخرج لهم الذكريات – غير ذي فائدة لهم؟ لم تقل شريير إن حديث الأطفال مع الكبار لا نفع فيه، لكنها حذرت من أن تحويل ذلك إلى علاج منظم قد يجلب من الضرر أكثر مما يجلب من الخير.
ذلك أن الأطفال، أكثر من البالغين، يتكيفون مع ما نغرسه فيهم، فإذا دفعناهم إلى التركيز على مشاعرهم الصعبة، تفاقمت هذه المشاعر واستحكمت، بدل أن تهدأ وتخبو. ومع ذلك، فهذا هو ما يفعله العلاج النفسي للأطفال، حيث تُبذل الجهود في دفعهم إلى ملاحظة مشاعرهم، والتعبير عنها، والحديث عنها، كأننا نتوهم أن الحديث عنها كفيل بأن يمحوها، أو أن يدفعها إلى الزوال في سحر غامض. ولكن ما جربته في عملي كان يتفق تمامًا مع ما كشف عنه البحث العلمي: فالأطفال إذا أُدخلوا في هذه المتاهة، وقعوا في أسر مشاعرهم، واستحكمت عليهم مخاوفهم، وأصبحوا أكثر قلقًا مما كانوا عليه حين جاؤوا يطلبون العون. أذكر كيف كنت أطلب من الأطفال أن يعبّروا عن مخاوفهم، و أن ينقلوها إلى صندوق الرمل، و أن يصفوا شعورهم في أجسادهم، و أن يتحدثوا عن الكوابيس التي تفزعهم، وكيف كنت أشعر أنني أساعدهم في استكشاف عالمهم الداخلي، فإذا بهم، على العكس، يغوصون فيه غوصًا حتى يغرقوا.
إن كان هناك من جدوى في تقنيات معينة، فهي تلك التي تُستخدم في علاج القلق الاجتماعي، والرهاب، ونوبات الهلع. وهذه تقنيات تستند إلى خبرة عريقة، استمدت من البوذية، ومن الفلسفة الرواقية، ومن حكم القدماء، فتعلم الإنسان كيف يعيد توجيه أفكاره حين تجرّه إلى متاهات لا فائدة فيها. ولكن لماذا، إذن، نُلقي بالأطفال إلى أعماق مشاعرهم الصعبة؟ لماذا نُفسد فطرتهم التي تدفعهم إلى تجاوز الأزمات والبحث عن الجوانب المشرقة؟ إن في هذا ما يعطل عملية الصمود الطبيعي لديهم، وما يدفعهم إلى التركيز على الألم بدل أن يكتسبوا القوة لمواجهته، وكأننا، ونحن نظن أننا نساعدهم، إنما نحبسهم في سجون لا مفتاح لها.
لم تكن العلّة، إذن، في الأساليب العلاجية التي تتبناها المدارس فحسب، بل تجاوز الأمر ذلك حتى أصبح فكرة ثقافية واسعة الانتشار، تتغلغل في طرق التربية ذاتها، حتى أضحت المشاعر هي المحور الذي يدور حوله كل شيء، بينما هي في حقيقتها لا تعدو أن تكون انعكاسًا مشوشًا، عابرًا، لحقيقة الواقع. فلو تدبّر المربون الأمر على وجهه الصحيح، لعلموا أن الغاية من تنشئة الطفل لا ينبغي أن تكون تنمية حساسيته الشعورية فحسب، بل لا بد من أن تتجه، قبل ذلك وبعده، إلى تقوية ملكاته التنفيذية، حتى يبلغ من النضج العقلي والانفعالي ما يبلغه الراشدون. وهذا يقتضي أن يُدرَّب على إدراك أن ما يشعر به ليس دائمًا مرآة صادقة لما هو كائن، وأن المشاعر إذا تُرك لها العنان بلا ضابط، قيدت الإنسان واستعبدته، وحالت بينه وبين النظر إلى الأمور على وجهها الصحيح. وليس من الحكمة أن يُعامل غضب الطفل كما لو كان أمرًا مقدسًا لا ينبغي المساس به، ولا أن يُكافأ سلوكه الصعب بمنحه امتيازات خاصة تشجعه على التمادي فيه.
ولعلنا نجد في قصة جيم بي مثالًا واضحًا لما نقول: فقد اتصل والداه، وقد استبد بهما القلق، يشكوان أن طفلهما لم يعد يقوى على ضبط انفعالاته، وأنه قد أصبح يثور على رفاقه بلا سبب ظاهر. ولم يكن الوالدان، كما قد يظن بعض الناس، من أولئك الذين يقسون على أولادهم، أو يعاملونهم بجفاء، بل كانوا على العكس من ذلك، يغمرونه بحبهم ورعايتهم. فلما ضاقا بما رأياه منه، لجآ إلى معالجة نفسية مشهود لها بالكفاءة، فكان أن أوصتهما بأن يمنحاه الفرصة ليعبر عن مشاعره بحرية، وكان ذلك يعني في كثير من الأحيان أن يطلق جيم العنان لغضبه بين أيديهما، وأن ينفعل عليهما دون حرج.
ولكن الأيام مضت، ولم يثمر هذا الأسلوب إلا عن ازدياد اضطراب الطفل. فلما رأى والداه أنه قد بدأ يواجه مشاكل في مدرسته، عادا إلى المعالجة يسألانها النصيحة، فأشارت عليهما هذه المرة باتباع منهج يُعرف اليوم باسم "النهج المستنير بالصدمات". ولم يكن قد خطر لهما من قبل أن وفاة أحد أفراد الأسرة، حين كان جيم صغيرًا، قد تكون هي السبب في ما يعانيه اليوم، ولكن المعالجة أقنعتهما أن هذا هو التفسير الصحيح لما يجري. فقد أصبح الغضب الذي يعتري جيم مفهومًا، بل متوقعًا، بل طبيعيًا تمامًا في سياق تجربته العاطفية المبكرة.
وهكذا، شُرع في تطبيق أسلوب جديد في إدارة سلوكه، يهدف إلى منحه شعورًا بالأمان في اللحظات التي يعجز فيها عن ضبط نفسه (وهي عبارة مخففة تعني أنه كان يصرخ، ويركل، ويضرب من حوله). فكان يُسأل عما يحتاج، ويُحتفى بمشاعره، ويُمنح الفرصة لممارسة أنشطة يحبها، كأن يلعب بألعابه المفضلة، حتى يعيد الارتباط بمن حوله. ولم تقتصر هذه الفلسفة على المنزل، بل امتدت إلى المدرسة أيضًا، حيث خصص له عامل دعم طلابي، يكون حاضرًا لملاعبته كلما أخل بنظام الفصل. وكان القائمون على هذا النهج يرون أن تعزيز علاقات الطفل بمقدمي الرعاية سيمنحه الإحساس بالأمان، وسينعكس ذلك على سلوكه، فيعود إلى الاتزان والانضباط.
لكن النتيجة لم تكن كما توقعوا، فقد وقفت الأم، دامعة العينين، تقول: "لكن ذلك لم يحدث". فقد انتهى الأمر بابنها إلى أن يُفصل من المدرسة، بل إنه صار يرفض الذهاب إليها من الأصل.
على أن الأمر لم يكن مجرد اجتهادات فردية بلا سند، بل كانت تلك الأفكار مستندة إلى أدبيات نفسية واسعة النطاق، تتحدث عن أهمية الارتباط العاطفي، وتأثير الصدمات في تشكيل السلوك. ولم تكن المدارس، ولا الأخصائيون، يعملون بمعزل عن هذه النظريات، بل كانوا يتلقون تدريبات إلزامية فيها. ومع ذلك، لم تُجدِ هذه الوسائل نفعًا، لأن جيم لم يُدرَّب على التحكم في غضبه، بل دُفع إلى الانغماس فيه. لم يُعلَّم كيف يسبق انفعاله بتوقع ما سيحدث، ولم يُحفَّز على التغلب عليه، بل على العكس من ذلك، وجد أن صراخه، وعنفه، وفوضويته، تُكافأ بامتيازات تجعله يفضلها على الدراسة والعمل. وهكذا، على الرغم من أن والديه لم يدخرا وسعًا في رعايته، لم يكن ذلك كافيًا لانتشاله من مصير العزلة، لأن التربية التي تلقاها لم تُكسبه الأدوات التي يحتاجها ليكون جزءًا من المجتمع، بل جعلته أسيرًا لنزواته، تائهًا في دوامة من الانفعالات التي لا ضابط لها.
ومن هنا، بدأت أتأمل فيما كنت أقوم به من عمل، وأتساءل: هل نحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذه الأساليب التي نجربها على الأطفال؟ هل من الحكمة أن نتركهم يغرقون في مشاعرهم بدلًا من أن نعلمهم كيف يعبرونها إلى بر الأمان؟ وأخذت أميل، يومًا بعد يوم، إلى الاعتقاد بأن هذه الفلسفة قد تضر أكثر مما تنفع، وأن هذا الهوس العلاجي بمشاعر الطفل قد يكون عقبة في طريق نموه بدلًا من أن يكون عونًا له.
نظرًا لأن فرضية مركزية في العلاج النفسي للأطفال – مساعدة الأطفال على استكشاف المشاعر الصعبة – تبدو بشكل متزايد وكأنها تحمل خطر التسبب في أذى علاجي (أي أن العلاج نفسه يكون ضارًا). ولهذا، وجدتني أنصرف عن العمل مع الأطفال، وأتجه بدلًا من ذلك إلى العمل مع آبائهم، وإلى معالجة المشكلات من جذورها في البيئة التي تحيط بهم، لأنني رأيت أن تقويم الأساس خير من تجميل الظاهر، وأن تعليم الطفل كيف يضبط نفسه أولى من أن نتركه فريسة لعواطفه، ثم نبحث بعد ذلك في كيفية التعامل معها.
إذا نحن تدبَّرنا الأسس التي قامت عليها الأخلاق الغربية، وجدناها مستمدة مما خلفته الفلسفة اليونانية القديمة، وما ورثته المسيحية من تعاليم في الفضيلة والتواضع والتفكير النقدي. على أن هذه الأسس، على متانتها، لم تَسلم من عوامل التغير التي طرأت على الحضارة الأوروبية، حتى غدت شيئًا آخر غير ما كانت عليه، بل إنها قد بلغت اليوم مبلغًا من الانحراف جعلها تفقد توازنها، فبدلًا من أن تكون الفضيلة والتواضع فضيلتين متلازمتين، لا تقوم إحداهما إلا بقيام الأخرى، إذا بنا نرى أنهما قد انقلبتا إلى شيء مختلف أشد الاختلاف، وأصبحا يتجسدان في صورة ذلك العميل الذي يرى نفسه ضحية، وذلك المعالج الذي يتقمص دور المنقذ، في مشهد لم يعد يحمل من معاني الفضيلة إلا قشورها. وأما التفكير النقدي، الذي كان ينبغي أن يكون وسيلة الإنسان لإعادة النظر في العقائد المتوارثة، فقد أصبح هو ذاته أداة لقمع أي نقد يُوجَّه إلى الأفكار العلاجية أو الأيديولوجيات السائدة.
وقد اعتدنا أن نُجلّ التفكير النقدي، وأن نزعم لأنفسنا أننا نفرط فيه، لكننا إذا تأملنا قليلًا في واقع الأمر، رأينا أن هذا الزعم ليس في كل حاله صحيحًا، فلو كان كذلك، لكان حريًّا بنا أن نلحظ أن 10٪ من العملاء الذين يلجؤون إلى العلاج النفسي لا يتحسنون، بل يسوء حالهم، وأن هذا العلاج الذي يُفترض أن يكون وسيلة للخلاص قد يصبح في بعض الحالات سببًا في تعميق الأذى. فإذا قيل للمرء إن عليه أن يستمع إلى مشاعره، وإن هذه المشاعر، مهما تكن عارضة أو شخصية، هي حقيقته المطلقة، فلا عجب إن وجد نفسه عاجزًا عن التغاضي عن الصغائر في علاقاته، غير قادر على الترفع عن ما كان يسيرًا تجاوزه. وإذا قيل له بعد ذلك إن فشله في هذه العلاقات ليس مرده إلى اختياراته أو طباعه، بل إلى قصور والديه عن تلبية احتياجاته في طفولته، فماذا ننتظر غير أن يصبح أشد قسوة في الحكم عليهم، وأبعد ما يكون عن التسامح معهم، في الوقت الذي يكون أحوج ما يكون إلى تلك الرابطة التي قد تمنحه شيئًا من الطمأنينة في عالم مضطرب؟
وليس هذا مجرد استنتاج نظري، بل هو أمر تدعمه الإحصاءات، إذ نعلم أن أكثر من ربع الأمريكيين قد قطعوا العلاقة بأحد أفراد أسرتهم، وليس من المعقول أن يكون كل هؤلاء قد عانوا من إساءات جسيمة تبرر القطيعة. ومع ذلك، فإن هذا الموضوع لا يُبحث في مؤسساتنا التدريبية، ولا يُثار بين المختصين، حتى لكأننا نخشى أن نراه على حقيقته، كما قد يخشى البعض أن يرى الجانب المظلم من النظام الاقتصادي الذي يؤيده، أو من التقنية التي يقدسها. وليس هذا من الحكمة في شيء، فإن مهنةً مثل العلاج النفسي، تعطي لفرويد وكارل يونغ ما تعطي من الاهتمام، ينبغي لها أن تُولي "الظل" القدر ذاته من العناية، لكنها تأبى أن تُبصر ظلها هي، ذلك الظل الهائل الذي يحيط بها، ويجعلها أحيانًا مصدرًا للضرر بدلًا من أن تكون طريقًا للخلاص.
وليس غريبًا أن نجد هذا الانحراف متصلًا بشعور طاغٍ بالفضيلة، يجعل من العلاج النفسي ما يشبه العقيدة التي لا تُساءل، ويؤدي إلى نشر أفكار غير مثبَتة، وربما ضارة، من الثقافة العلاجية إلى ثقافة المجتمع كله. فمن كان يصدق أن الضيق الذي يعانيه الإنسان في حياته اليومية سيُفسَّر ذات يوم على أنه أثر لصدمة تعرض لها في صغره، أو نتيجة لإساءات زُعِم أنها وقعت عليه من والديه؟ ومن كان يظن أن أطفال المدارس، الذين يحتاجون إلى قواعد واضحة وحدود ثابتة، سيُحرَمون منها بحجة أن الصدمات التي مروا بها تقتضي معاملتهم معاملة خاصة، فينشأون بلا أدوات تمكنهم من النجاح في عالم الكبار؟
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك حتى أصبحت نظريات الصدمة، بكل ما فيها من مغالاة، تُقنِع فئات كاملة من الناس أنهم معطوبون، محتاجون إلى علاج دائم، لا قِبَل لهم بمواجهة الحياة إلا بمعونة من يُشخِّص لهم أمراضهم، ويُقدّم لهم خلاصهم. ومما يزيد الأمر عجبًا، أن هذه الأفكار تروَّج كما لو كانت حقيقة مطلقة، وكأن جميع الثقافات الأخرى لم تفهم من قبل كيف تتعامل مع الألم والمعاناة، أو كأن الحضارات الإنسانية، قبل فرويد، لم تكن تدرك طبيعة النفس البشرية.
وليس بعيدًا عنا مثال سريلانكا، التي عانت من حرب أهلية طاحنة، ثم من كارثة التسونامي، ولم تنظر إلى ما جرى لها على أنه صدمة تستدعي تدخلًا نفسيًا. بل إنه لما جاءت جحافل المعالجين النفسيين الغربيين بعد تسونامي 2004، لتلقّن الناس أن ما أصابهم هو "صدمة"، خرجت جامعة كولومبو ترجُوهم أن يكفّوا عن ذلك، لأن هذا التفسير كان يقوض صلابة المجتمع، ويجعل الناس أكثر ضعفًا بدلًا من أن يساعدهم على التعافي. والعجيب في الأمر أن سريلانكا، التي رفضت إنجيل الصدمات، احتلت المرتبة الأولى في تقرير "الحالة العقلية للعالم" لعام 2023، وكأنها بذلك تقدم للعالم برهانًا عمليًا على أن البشر ليسوا بحاجة إلى أن يُقنَعوا بأنهم مرضى لكي يجدوا السكينة.
فلماذا نحن، على خلاف سائر الأمم، نصرّ على أن الأحداث السيئة تترك في النفوس ندوبًا لا تزول، وتشوه إلى الأبد نظرتنا إلى الحياة؟ ولماذا نزيد من وطأة المعاناة بالإصرار على أن "الصدمات تُحفظ في الجسد"، بحيث لا يمكن الفكاك منها؟ إن إقناع الإنسان بأنه قد تضرر إلى الأبد، وأنه لن يكون قادرًا على النهوض بعد ما أصابه، لا يؤدي إلا إلى إشاعة روح الاستياء، وتدمير العلاقات الإنسانية. فإن كنت ممّن يروّجون لمثل هذه الأفكار، أو حتى يؤمنون بها، فلعلك تُحسن إن تأملت في مدى هشاشة الأسس التي قامت عليها.
ولئن كان العلاج النفسي يتحدث عن الحاجة إلى فهم الثقافات الأخرى، والتعلم منها، فإننا لا نكاد نراه يطبق هذا المبدأ على نفسه. وأحسب أنه لو فعل، لكان في وسعه أن يتعلم شيئًا من تلك النظرة المختلفة إلى المعاناة، التي ترى الألم جزءًا من الحاضر، لا لعنةً تلاحق الإنسان من الماضي، ولا شبحًا يطارده إلى الأبد.
إذا نظرنا في أمر العلاج النفسي، ورأيناه وقد صار أداة رئيسة يتوسل بها الناس إلى مواجهة صعوباتهم، فهل يسوغ لنا أن نتساءل: أليس في هذا التطبيع خطر؟ فإننا إن تدبرنا طبيعة هذه العلاقة التي تجمع بين المعالِج والمريض، وجدناها علاقة تشبه الصداقة، ولكنها صداقة غير متكافئة، قائمة على التفاوت لا على التبادل، بحيث لا يكون المعالج إلا ذلك الطرف الذي أُعدَّ لخدمة الآخر، لا يسعى إلى منفعة شخصية، وإنما يُوجِّه كل اهتمامه إلى حاجات مريضه، حتى لكأن الأمر لا يختلف كثيرًا عن تلك المهنة التي قد يراها الناس على اختلاف مذاهبهم شيئًا مستنكرًا، وأعني بها مهنة من يبيعون أجسادهم. فإنما العلاقة في كلا الحالين قائمة لا لذاتها، بل من أجل الطرف الذي يؤدي الثمن، وهذا الثمن – ماديًا كان أو معنويًا – هو الذي يخل بميزان التبادل، ويجعل العلاقة تدور حول صاحب الحاجة وحده.
وإن شئنا أن نتمادى في التأمل، قلنا إن العالم لو كان على ما ينبغي له أن يكون من الكمال، لما احتاج الناس إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، إذ كانت علاقاتهم تقوم على الفهم المتبادل، والتكامل الطبيعي بين الجنسين، والتواصل الصحي بين الأفراد. ولكن العالم لم يكن يومًا كذلك، ولن يكون، ومن ثَمَّ وجد المعالجون ووجد غيرهم، ليملأوا فراغًا أوجدته الحياة في النفوس، فيهيئون للناس شيئًا مما يفتقدون، ويتيحون لهم فرصة التأمل في ذواتهم، عساهم يبلغون في يوم من الأيام ذلك النضج الذي يمكّنهم من بناء علاقات حقيقية، قائمة على أساس متين.
ولكن مكمن الخطر أن ينقلب العلاج، من كونه وسيلة إلى الغاية ذاتها، فإذا بالمريض لا يعود يطلب العلاج ليعينه على الحياة، بل يتخذ منه مهربًا منها، وإذا بالمجتمع لا يعود يرى في العلاقات الإنسانية ملاذًا، بل يدفع الناس إلى حمل أعبائهم إلى الجلسات العلاجية، بدلًا من أن يواجهوها بين ذويهم وأصدقائهم. وما ذلك إلا لأن العلاقات الحقيقية لا تكون إلا بتلك المحادثات الشاقة، وذلك الصراع بين الآراء الذي لا غنى عنه في نمو المجتمعات وتطورها.
فليس ينبغي إذًا أن يكون الفضاء العلاجي حاجزًا يحجب الإنسان عن مواجهة نفسه وعن مواجهة الآخرين، وإنما ينبغي له أن يكون معملًا، يُهيَّأ فيه المريض، ويستعد لملاقاة الحياة، على أن يكون ذلك كله بنية واضحة، لا تزيغ عن إعادة الإنسان إلى مجتمعه، بعد أن يكون قد أدرك من نفسه ما لم يكن يدرك، واستعد لما كان يعجز عنه. وأعود إلى ذلك التشبيه الذي سقناه آنفًا، فأقول إن العامل في تلك المهنة المشينة، لا ينبغي له أن يطمح إلى أن يحل محل الزوج أو الحبيب، بل أقصى ما يجوز له أن يكون هو ذلك الإنسان الذي يفتح أمام الآخر أفقًا جديدًا في الوجود، عسى أن يثمر ذلك في حياته الحقيقية، ويجعل منها ما هو أنبل وأجمل.
غير أن هذه الأمور جميعًا لم تكن لي إلا مثارًا للحيرة، ومعضلة تتطلب حلًا، فما عسى أن يصنع المعالج، إذا هو أيقن بكل هذه العيوب، وأدرك كل هذه المخاطر، لكنه لم يجد لنفسه سبيلًا غير المضيّ في عمله؟ هل له أن يوفق بين هذا الوعي الذي أصابه، وبين ما يقوم به من عمل؟ لم أجد لهذا السؤال جوابًا قاطعًا، وإنما هي محاولات لم تكتمل، وتجارب لا تزال قيد التنفيذ.
ولهذا، لم أعد أعد المرضى بشيء، ولا أزعم أنني أملك أسرار العلاج، أو أُفاخر بما تلقَّيت من تدريب في مدارس التحليل النفسي. إنما الأمر مناقشة، محادثة، نظرة في الحياة، لا أقدم فيها أكثر مما قدمتُه لمن سبقني من العملاء، ومن ظن أن ذلك نفعه، فله أن يجرِّب، ومن لم يظن، فلا إلزام عليه.
وقد حاولت أن أخرج من تلك الدائرة الضيقة التي رسمتها الأفكار الغربية خلال الخمسين سنة الأخيرة، فلم أجد بأسًا في أن ألتفت إلى ما هو أقدم وأعمق، وإلى ما صمد أمام الزمن، فلم يعبث به التغيير، ولم تنله يد التبديل، لأن ما بقي عبر العصور هو – لا شك – ذو قيمة. فمن البوذية أتعلم اليقظة الذهنية، لا على نحوها المشوه الذي روجه الغربيون، بل في ضوء مبادئها الثمانية التي تشمل الأفعال والأقوال والجهود. ومن وليام جيمس أستلهم البراغماتية، ومن نيتشه أستعير فلسفته في الإرادة والاختيار، ومن سقراط أتعلَّم فن الاستجواب، غير أني لا أجعل شيئًا من ذلك محورًا لجلساتي، وإنما يكون للعميل أن يقود الحديث حيث شاء، فهو حديث عن حياته، عن المعاني التي يضفيها على وجوده، وعن الطرق التي يختارها ليسير فيها.
فما العلاج إذًا، إن لم يكن احتفاءً بما هو حسن، وكشفًا عما هو سيئ؟ وما هو إلا فضاء نرنو فيه إلى المستقبل، لا نأسى على الماضي، ولا نغرق في جراحه. فإنما عمل المعالج هو أن يُعين الإنسان على أن يرى أخلاقياته وجمالياته، فإن الأخلاق في أصلها لا تعدو أن تكون تجسيدًا لما نراه حسنًا وجميلًا، وما يبدو لنا أنيقًا وصحيحًا، هو الذي نتخذه معيارًا، ثم لا نلبث أن نُلبسه بعد ذلك ثوب الفضيلة، فنزينه بحياد زائف، وكأن الأخلاق لم تكن في البدء سوى امتداد لحسٍّ جماليٍّ عميق.
أحسب أن جوهر العمل العلاجي الحقيقي ليس في تخفيف الألم أو التخفيف من حدّته، وإنما في مقاومة ذلك الاستياء الذي يتسلل إلى النفوس، فيفسدها من حيث لا تشعر. فإن الألم في ذاته أمر محتوم، لا مفرّ منه، غير أن الاستياء هو الذي يضاعف من وقعه، ويجعل احتماله أشد عسراً. والاستياء إنما ينشأ حين يشعر الإنسان أنه مظلوم بهذا الألم، وأن من حقه ألا يصيبه منه شيء، فإذا به لا يكتفي بالمكابدة، بل يضيف إليها ذلك التمرد الذي يجعل أوجاعه تضطرم في صدره، وتزيده عذاباً على عذاب.
ولعل هذا التعقيد الذي يكتنف الأمر راجع إلى أن الاستياء يتصل بتصور الإنسان لحقوقه، بل يتشابك مع السياسة ذاتها، إذ ما الحقوق إلا مواضع الخلاف بين الناس، وما السياسة إلا ميدان المطالبات والاستحقاقات. فإذا ظننت، مثلًا، أن من حقي أن أنشر مقالي في صحيفة "نيويورك تايمز"، أو أن من حقي ألا أتأثر بالنقد الموجه إليه، ثم جاء الواقع على غير ما أريد، فرُفض مقالي، وقُوبل بما يكره الكاتب من الانتقادات القاسية، فهل تظن أن ألمي سيقتصر على الإحساس بالرفض؟ كلا! بل سيزداد أضعافًا، لأن إحساسي بالاستحقاق سيجعل هذا الألم مضاعفًا، وسيوسع من رقعته، ويجعله ممتدًا في نفسي، لا يقف عند حد.
على أني أرى أن خير ما يواجه به المرء هذا الإحساس المرهق، ويقي به نفسه شرور الاستياء، إنما هو التسامح والامتنان، فهاتان الخلتان – فيما أعتقد – أصدق ما يعيننا على المضي في الحياة دون أن تستبد بنا مشاعر الغبن، ودون أن نغرق في تلك المطالب التي لا تنتهي، والتي لا تزيدنا إلا وجعًا.
لاحظ أني قلت "أرى"، ولم أقل "أعلم". فإنما أقول ما أقول لأنه يناسبني، ويجد صداه في نفسي، لا لأني أزعم امتلاك الحقيقة المطلقة. ولقد كان هذا الرأي موضع نظر عند غيري من قبل، لا في الفكر الفلسفي فحسب، بل في تراث الأديان أيضًا، من تعاليم سيدهارتا غوتاما إلى مواعظ المسيح الناصري، ومن تأملات نيتشه إلى رؤى غيره من المفكرين. ولعل بساطة هذه الفكرة هي التي تجعلها أكثر قبولًا عند الناس، لأنها تتيح لكل امرئ أن يختبر صحتها بنفسه، فلا يحتاج في ذلك إلى أن يتلقى التفسيرات الغامضة، ولا إلى أن ينقب في ذاته عن عقد نفسية خفية، ولا إلى أن يسلم أمره إلى معالج يزعم أنه وحده القادر على كشف أغوار نفسه.
بل قد أتعلم أنا نفسي من مرضاي! فإن أصرت إحداهن، مثلًا، على أن من الممكن أن يجتمع في القلب الإحساس بالحق والامتنان معًا، فقد يكون عليّ أن أنصت إليها، وربما أقتنع بما تقول، ولقد حدث هذا بالفعل، وأشهد أني تعلمت منها، فشكرًا لها، وإن قرأتْ كلماتي، فهي تعلم أنني أعنيها.
ولما رأيت أن كثيرًا مما يُقال في العلاج ليس إلا أوهامًا نظرية لا طائل منها، نبذتُ عني هذه الفرضيات التي لا تغني ولا تسمن، وقلت للمرضى قولًا صريحًا، لا التواء فيه ولا تورية: لا تنتظروا مني حلولًا سحرية، فإن حياتكم أنتم الذين تصنعونها، وليس لي أن أقرر عنكم ما ينبغي أن تفعلوه.
وإذ فعلت ذلك، وجدتني أقترب من تلك الحكمة العريقة التي ترددت أصداؤها عبر القرون، وتوارثها الناس جيلًا بعد جيل، لا لأنها مقدسة، بل لأنها أثبتت نفعها، وأظهرت جدواها. لم أعد أرى نفسي معالجًا نفسيًا، بقدر ما صرت رفيقًا في رحلة الإنسان نحو فهم ذاته، فأنا أغوص معه في أعماق تجربته، وأصغي إلى قصصه، وأتأمل ما يعرضه عليّ من مشكلات، وأكتشف معه عوالمه، كما يكتشف الرحالة أراضي لم تطأها قدماه من قبل، فلا يدع حجراً دون أن يقلبه، ولا سرًا دون أن يسبر غوره.
وقد يكون هذا المنهج الجديد أهون عليّ من حيث المسؤولية، لأنني لم أعد أشعر أنني ملزم بشيء، فلم يعد عندي ما "يجب" أن أفعله، ولم أعد أحمل همًّا فوق ما أطيق. ولكن، من ناحية أخرى، وجدت أن المسؤولية باتت أعظم، لأنني الآن أقابل المريض بما هو عليه، دون أن أضع بيني وبينه نظريات غامضة، أو فلاتر تُشوه حقيقته، أو تفسيرات تدّعي أنها أقرب إلى الصواب.
لقد تخليت عن النظرية العلاجية، وأحسب أنني بذلك أصبحت معالجًا أفضل، وأقرب إلى الإنسان، وأكثر قدرة على أن أراه بعين مجردة، لا تخدعها الافتراضات، ولا تغشيها الأوهام.
مترجم من Aeon بقلم نيكلاس سيرنينغس طبيب نفساني وأخصائي علاج نفسي في بريستول ، المملكة المتحدة.
إذا أردت أن تُدّعم المحتوى الثقافي المقّدم لك بثمن كوب قهوة فهذا يسرنا كثيراً، فقط اضغط على الزر التالي