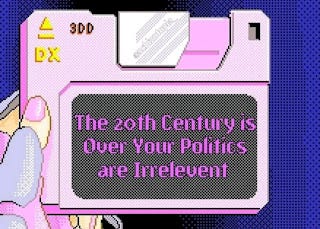تم نشر هذا المقال في الأصل باللغة الإيطالية في العدد رقم 7 ، ثم ترجم باللغة الإنجليزية على Reinintamento . كان المقصود في الأصل حصريًا لجمهور إيطالي ، وأخذ البيئة السياسية الإيطالية كسياق. في حين أن معظم ما يقال في المقال صالح لمعظم اليسار الغربي ، فإن بعض التصريحات قد تخضع للواقع السياسي للبلدان الأخرى و قد تصح هذه المبادئ فى قيادة المشروعات و الأعمال العامة عموماً.
منذ خمس سنين بدأت رحلتي في عالم التنظيم، أو ما يسمّيه أهل اللغة الإنجليزية Organizer، لفظٌ غامض في ظاهره، واسع المعنى في باطنه، يشمل من يعملون في صلب السياسة لا من أطرافها: النقابيون المحنّكون، والمتحمّسون من المتطوّعين، وبناة الحركات، والذين يشكّلون المجتمعات، سواء كانت مادّية تُرى وتُلمس، أو رقميّة تُكتب ولا تُمسّ. وهم أيضًا الميسّرون، والميسّرات، ومنسّقو الجماعات، وحلقات الدراسة، والأحزاب، والبيوت المحتلة، والفرق شبه العسكرية، والجمعيات التي لا تعلن عن نفسها. وإن كان غموض هذا الاصطلاح يثير الحيرة، فإننا في إيطاليا قد زدنا الحيرة حيرة، إذ لا نملك اسمًا واحدًا يجمع أولئك الذين يُتقنون هذا الصنع، ولا نحب المصطلحات التقنية، بل نزهد فيها زهدَنا في الطعام البارد شتاءً.
ولقد كانت تجربتي الأولى في هذا الميدان تجربة غريبة، بل تجربة مشوشة مضطربة. فقد كان فرع برلين من "ائتلاف عمّال التكنولوجيا" قد نشأ لتوّه، وكنتُ أحد مؤسّسيه، إلى جانب يوناتان ميلر. ولم أكن أعلم عن الأمر شيئًا، ولا كنت أملك من الخبرة أو الاطلاع ما يؤهّلني له، ناهيك أن أتصدّر موقعًا قياديًا.
ولست أُنكر أن ما جرّني إلى هذا كله هو رغبتي في أن أُدير مجموعة دراسة تبحث في علاقة التقنية بالسياسة، ولهذا السبب قبلت المنصب، وإن لم يكن لدي ميل خاص لتنظيم عمّال التكنولوجيا. غير أن الأمور لم تلبث أن تفلّتت من بين يديّ كما يتفلّت الماء من الكفّ.
أما في العمل، فقد كنت أعمل في شركة ناشئة تطوّر خوارزميات لضغط البيانات في سيارات القيادة الذاتية، وكنت أحتاج، لأسباب معروفة لي، إلى شيء من التخريب المنظَّم في إجراءات الشركة، حتى أظفر بقيلولة الظهيرة ولعبتي المفضّلة من ألعاب الفيديو. وقد قادني هذا التخريب البريء إلى مساعدة المدير التقني في مشروع غريب، أراد فيه أن يُدخل على الشركة نظامًا يُدعى "الهولاكراسي"، وهو مستوحى من نظام أقدم يُسمّى "السوسيوقراطية". وكلاهما في الظاهر يُشجّع على الإدارة الجماعية، ولكنه في الحقيقة يُمكِّن المدير من الإمساك برقابنا برفقٍ ظاهر وشدّةٍ باطنة.
وهكذا بدأت مفردات لم أكن أحفل بها من قبل تتسرّب إلى حياتي اليومية كمبرمجة: كالتنظيم، وبناء الفريق، وإدارة التغيير، وتصميم العمليات. ولست أُنكر أنني ما كنت أرى في هذه الأمور إلا تعقيدًا لا حاجة لي به. لكنني حين اقتربت منها، وحين لامست تفاصيلها، أدركت أن لا سياسة فعالة بدونها، ولا قيلولة مضمونة إلا بحمايتها من المديرين.
غير أنني لم أكن مرتاحة لهذا العالم الجديد. كنت أحس في طيّاته شيئًا لا يُطمئن القلب: سِلسلة من الصدمات، والمواقف الغريبة، والمعتقدات الموروثة، والطقوس التي لا فائدة فيها، تُميّز ما يسمّونه سياسة الحركات، أو ما يحبّ البعض تسميته "السياسة الشعبية". وكان في الأمر أيضًا هياكل قديمة للنقابات والأحزاب، فيها عجزٌ مقنَّع، وفيها صراعٌ بلا معنى، وفيها طاقة تُهدر كما يُهدر الماء في الأرض السبخة. ولم يكن هذا يُعجبني في شيء، بل كنت أراه أشبه بنظام لا يُجيد غير الفوضى، ولا يُنتج غير الفشل.
لطالما فهم الناس "السيطرة" على أنها القمع، وكأنها يدٌ غليظة تُطبق علينا من الخارج. ما خطر لأحد، أو قل ما خطر لأكثرهم، أن تكون السيطرة وسيلة من وسائل الحرية، وأن تكون سبيلاً من سُبل الخلاص، إذا كانت صادرة عن الجماعة، وموجهة للجماعة، تمارسها باختيارها لا بقسر الآخرين عليها.
وكانت لي ملاحظة لم تبرح ذهني، وهي أن وعيًا جديدًا آخذٌ في التشكُّل، لا في بلادنا وحدها، بل في دوائر أميركية، وفي تجارب أوروبية حديثة، كحركة "تمرد الانقراض"، وحملة "الجيل الأخير". هناك، كان الناس يتحدثون عن اللوجستيات أكثر مما يتحدثون عن الشعارات أو حتى التكتيكات. قالها الجنرال عمر برادلي يومًا: "المبتدئون يتحدثون عن التكتيك، أمّا المحترفون فيدرسون اللوجستيات". وقد صدق، فلوجستيات التنظيم السياسي هي ما يصنع الفرق: من توزيع الأدوار، إلى بناء الهياكل، إلى تسهيل الاجتماعات، وتنظيم المعرفة، واستخدام الأدوات الرقمية، وتنسيق الرسائل العامة.
كنت أرقب هذا بعين المستغرِب، لا المنكر. كان في داخلي انقطاع عن الماضي الذي انتميت إليه ولم أصنعه، شاركت فيه ولم أفهمه على وجه الدقة. وكان شعورًا غامضًا: لا أعلم أهو إحساسي وحدي، أم هو شيء تشاركني فيه نفوس أخرى تسير معي في الدرب.
وما زال الأمر كذلك حتى دعاني رجل اسمه دانييل غوتيريز، مكسيكي الأصل، أميركي الجنسية، إلى حلقة دراسية حول كتاب اسمه لافت: لا عمودي ولا أفقي: نظرية في التنظيم السياسي. ولم أكن قد سمعت به من قبل، ولا كنت أعرف كثيرًا عن دانييل نفسه، إلا أنه رجل عملي، حاد في منطقه، دقيق في عبارته، على الرغم من خلفيته الأكاديمية. وقد نظم الإضرابات في جامعته، ونجح فيها، وشارك في برلين في تنظيم المهاجرين ضمن "البدائل الأوروبية"، كما كان أحد منسّقي الحملة الشهيرة لمصادرة شقق "دويتشه فونن"، التي كان النصر قريبًا منها آنذاك.
وكان الكتاب عجيبًا، كما كانت المناقشات التي دارت حوله أعجب. شارك فيها من يسميهم الناس "المنظّمون": أميركيون، برلينيون، نقابيون، بنّاؤون للحركات، أناس جاءوا من الأحياء الصغيرة، يحملون معهم تجاربهم البسيطة، وأحلامهم الكبيرة.
وفي هؤلاء الناس، وفي صفحات ذلك الكتاب، وجدت ما عبّر أخيرًا عن عدم الرضا الذي يسكنني منذ سنوات. لم أعد وحدي، ولم أعد بلا لسان. كنت أكافح في نفسي رغبة في التحكم، وميلًا إلى الأبوية، فلم أكن أُسرّ إلا حين قيل لي بوضوح: إن نظامًا سياسيًا يُنتج الهزائم ينبغي تغييره، لا الدفاع عنه. وأولئك الذين يتمسكون بالتقاليد السياسية كما يتمسك الأطفال بلعبهم القديمة، ويصرّون على الطقوس وإن كانت بلا فائدة، هم – في الحقيقة – جزء من المشكلة.
فالخسارة المستمرة ليست بطولة، والاستشهاد بالنفس لا يصنع نصرًا، وادّعاء التفوق الأخلاقي لا يؤهّل أحدًا للقيادة. السياسة لا تدار بنقاء النية وحدها، بل بالكفاءة، وبالإرادة التي لا تخجل من أن تكسب. وقيل لي أخيرًا، وأراحني ما قيل: "لا عيب في أن تريد أن تنتصر. لكن لتنتصر، لا بد أن تتسخ يداك".
قد مضت خمس سنوات، منذ أن فُتح لي هذا الباب الغريب — بابٌ لم أكن أعلم بوجوده، ولم أكن أعرف أن السياسة يمكن أن يكون لها وجه كهذا. وهو باب فَتحه لي عمل رودريغو نونيس، فدخلت منه إلى فهمٍ جديدٍ تمامًا، مختلفٍ من الأصل، لما تعنيه "العمليات السياسية". وقد تعلّمت، مع الوقت والتجربة، أن أسمي هذا الفهم: "الشمولية السياسية".
وما الشمولية السياسية؟ هي حال من الوعي المتحوّل، من الإدراك المتبدّل. هي صورة للسياسة لا تشبه ما ألفناه، فهي مزيجٌ من عوامل كثيرة: أشخاصٌ يعقلون ويفكرون، وصراعات بين الأفكار، واندفاعات من الإرادة التي تكاد تمسّ السحر، وتمثيلٌ للناس، وشهادةٌ على ما يقع. إنها فوضى، أو إن شئت قلت: هيجان سياسي، كل شيء فيه متصل، لكنك لا تقدر أن تعرف كل شيء. ومع ذلك، فإنك لا تستطيع أن تتجاهل شيئًا، إن أردت أن تكون ممن يربحون.
وفي هذا المقال، لا أريد أن أكتب بحثًا في الفلسفة السياسية، ولا أن أقدّم نظريّة مغلقة لا يدخلها إلا الخواص. بل أريد أن أشارك القارئ بعض المعاني التي رأيتها بعيني، وخبرتها بخطاي، حين تغيّر فهمي للسياسة. وسأروي ما أروي من موقفي، من ذاتي، لأنني على يقين أن السياسة لا تُمارَس إلا من الداخل. من حيث يكون الإنسان حيًّا، من حيث يكون في قلب التاريخ لا على هامشه. أما من يظن أن السياسة رؤيةٌ من الخارج، فذاك — عندي — واهم في الحداثة، لا يعرفها ولا يفهمها.
وقد يُخيَّل إلى القارئ أنني سأقدّم شيئًا مترابطًا، متماسكًا، يبدأ من المقدمة وينتهي بالخاتمة. ولكني لن أفعل. فما عدت أطيق "البطولة الفكرية" كما يسمونها، تلك التي تُتعب القارئ وتُفسد عليه لذّة الفهم. ثم إن تقديم عرضٍ شاملٍ لموضوعٍ مثل "التنظيمات السياسية" أمر غير ممكن في مقال واحد، بل هو ضرب من الغرور الذي لا أريد أن أقع فيه.
لذلك، فإني سأقدّم ما يشبه الشعارات التربوية، أو لنقل "المانترات" التي تراكمت عندي مع السنين. وقد نشأت هذه المانترات من هنا وهناك: من كتب قرأتها — وعلى رأسها كتاب نونيس — ومن عبارات تبادلناها في التنظيمات التي عملتُ فيها، ومن جُملٍ ظهرت فجأة ونحن نعدّ الدورات، أو نعقد ورش العمل، أو نخطّط لحملة سياسية. وكل واحدة من هذه العبارات تصلح مدخلًا إلى فهم جانب من جوانب هذه "الكلية السياسية"، التي سأكشفها وجهًا وجهًا.
وقبل أن أبدأ، لا بد من كلمة أخيرة. قد يجد القارئ في لغة هذا المقال شيئًا من الخشونة، شيئًا من التراب، شيئًا من القصد المباشر دون زخرفة. وهذه قَصْدي، لا سهوٌ مني ولا ضعف. فإن موضوع التنظيم السياسي موضوع صعب في نفسه، فيه من التجريد والتعقيد ما يكفي. فلا حاجة إلى أن نثقله أكثر بمصطلحات غامضة، أو بإحالاتٍ إلى فلاسفةٍ ماتوا ولم يبقَ لهم أثر في الواقع، أو بعباراتٍ يُراد منها إظهار ثقافة الكاتب لا خدمة القارئ.
إن كنتَ تكتب بلغةٍ لا يفهمها الناس الذين تدّعي أنك تكتب لهم، فاعلم أنك نخبوي، متعالٍ، تخاطب نفسك لا الناس. وإن لم تكن قادرًا على أن تشرح المعقّد بلغة بسيطة، فالكتابة في السياسة ليست لك، فالتمس لك عملًا آخر.
وأما أنا، فإن كانت هذه الأفكار التي أقدّمها أفكارًا حقيقيّة، نافعة، حيّة — فإنها ستثبت، وستتقبّل عرضي العنيف هذا. وإن لم تكن كذلك، فإنها ستموت على هذه الصفحة، وتموت عن حق، ولا أسف عليها.
فلنبدأ.
١. المعرفة لا تُغيّر الواقع
دعنا نبدأ من حيث يشقّ الفهم، ويصعب التقبّل: أن تعرف شيئًا لا يعني أنك قد غيّرته. هذه حقيقة قد تكون مرّة على بعض النفوس، لكنها ضرورية إن أردنا أن نرى بوضوح. فالمعرفة، كما هي، لا تملك سحر التغيير ما لم توضع في سياقٍ يحدّد فائدتها أو ضررها، خاصة حين يتعلق الأمر بالعمل السياسي.
كثير من الحلقات اليسارية، ولا سيما تلك التي تغرق في التنظير والفكر الأكاديمي، تغفل عن هذا الأمر. إذ تُعامل المعرفة، والوعي، والحوار، وحتى التأمل الذاتي، وكأنها غايات بحدّ ذاتها، لا وسائل تقود إلى الفعل. فنقف عند منتصف الطريق، ونظن أننا قد بلغنا النهاية.
نبدأ نضع أفكارنا، وآراءنا، ومشاعرنا حول قضية من القضايا، أو حول مشكلة بعينها، أو حتى حول حلٍّ محتمل، في مركز الاهتمام. كأننا نعتقد أن تغيير رأينا في أمرٍ ما كفيل بإحداث التغيير الحقيقي في العالم. وهكذا، نُسند ـ دون وعي ـ إلى طرف غامض أو قوة غير مرئية مهمة تحويل هذا الوعي إلى فعلٍ سياسي واجتماعي. وغالبًا ما لا يحدث هذا التحول.
وفي بعض القضايا الحادة، كالانهيار المناخي مثلًا، نرى التناقض صارخًا بين ما تقوله استطلاعات الرأي، وبين ما يفعله الناس بالفعل، وبين ما تبثّه ثقافة هذا العصر من عادات واختيارات. لماذا؟ لأن هناك قوىً نافذةً تُعلي مصالح فئة قليلة مهيمنة ـ ما يمكن أن نسميه بالسلطة الظاهرة أو Potestas ـ على حساب الرغبة العامة في التغيير، تلك الرغبة التي تغذيها قوة خفية غير كافية أو Potentia.
ومن يفهمون جيدًا بنية السلطة التي نحيا تحتها، أفرادًا كانوا أو منظمات، لا يجدون صعوبة في تفسير هذا التناقض. بل إنّ ما قلناه للتو يُعدّ بديهيًا في بعض الأوساط. ومع ذلك، قلّما ينجح هؤلاء في استنتاج ما يمكن فعله فعلًا لتغيير هذه الممارسات. مرة أخرى، تُلقى مسؤولية الفعل على طرفٍ ثالث. نُشخّص المرض، ثم نُسكت عن الدواء.
أما الليبرالية، فهي تفترض افتراضًا ثابتًا: أن السياسة والفعل السياسي لا يكونان إلا في ميدان الحوار، حيث يتناقش أفرادٌ عقلاء مطّلعون، ومن الحوار يولد العمل. لكننا جميعًا رأينا، في الواقع، مدى هشاشة هذا النهج. حتى أولئك الذين يعلنون رفضهم لهذا التصوّر، والذين يرفضون تجسيده من خلال التصويت أو العمل داخل الأطر التقليدية، يعودون في ممارساتهم وكأنهم يؤمنون بأن تبادل المعلومات كافٍ للتغيير. فيُعيدون، بوجه جديد، إنتاج النظام نفسه الذي يعارضونه.
وكيف نعالج هذا الداء؟ نعالجه أولًا بأن نُعيد للآراء والنقاشات والمواجهات معناها الحقيقي، أي أن نُعيدها إلى دورها كوسائل لا كغايات. فالناس لا يغيّرون الواقع حين يتفقون على أمر، بل حين يربطون أقوالهم بالفعل. خذ مثلًا "قانون الحقوق المدنية" في الولايات المتحدة: حين صدر، كان أغلب الناس، بنسبة تصل إلى 85%، يعارضونه. ومع ذلك، مرّ القانون. كيف؟ لأن من ناصروه امتلكوا طاقة هائلة على الحشد، ظهرت في "مسيرة المليون رجل"، وامتلكوا كذلك قوة مسلّحة، مليشيات منتشرة ومدعومة من جمهور واسع، معظمهم من السود. وفي داخل هذا الحراك، كان النقاش ضروريًا، وكانت الخلافات موجودة، لكن الهدف كان واضحًا: التغيير.
ولعل الحديث عن المسيرات يقودنا إلى واحدة من أكبر مشكلاتنا: أن نظن أن مجرد الخروج إلى الشارع يُعدّ إنجازًا سياسيًا. ولكن هل التظاهر، في ذاته، يغيّر شيئًا؟ قلّما يحدث ذلك. أقصى ما يفعله هو كشف ميزان القوى، إظهار من الأقوى ومن الأضعف. وهذا الكشف، حين لا يكون في صالحنا، قد يؤذينا أكثر مما ينفعنا.
فكّر في النقابات: حين تريد أن تُظهر قوتها، تُخرج مئات الآلاف من العمال إلى الساحات. الحملات السياسية تفعل الشيء نفسه لتُثبت شرعيتها. لكن المشكلة أن هذه العروض، في بعض الأحيان، تُظهر ضعفنا لا قوتنا. فحين لا نحشد إلا مئة شخص لقضية نراها عظيمة، قد نحتفل نحن بما أنجزنا، لكن خصومنا يرون شيئًا آخر: أن لا أحد يهتم بهذه القضية، أو أن تأثيرها ضئيل. وهنا نكون قد كشفنا أوراقنا، وكان الأجدى أن تبقى مخفية.
وشعارنا "معرفة الأشياء لا تغيّرها" ليس دعوة للجهل، بل دعوة لنقد طقوسٍ ومفاهيم نشأت في زمن مضى، ثم استوعبها النظام الحالي وجعلها جزءًا من ثباته. نعم، المعرفة وحدها لا تكفي، ولكنها ضرورية. مجموعات الدراسة، والمنصات الإعلامية، ومراكز المساعدة، والتدريب العملي، كلها أدوات إن استُعملت بحكمة، تنمّي المهارات، وتُحرّك الطاقات، وتبني الموارد اللازمة للتغيير. لكن يجب أن تظل هذه الوسائل خادمة للهدف، مبرّرة بما نريد تغييره.
وقد قال لي صديق حكيم، اسمه سيلفيو لوروسو، قولًا بليغًا يصلح أن نختم به هذا الحديث:
"الكلمات لا تغيّر العالم. الكلمات، في أحسن أحوالها، تغيّر من ينطقون بها، فإن أرادوا، وإن استطاعوا، غيّروا العالم بأنفسهم."
ثانيًا: القوة قبل الشكل
هذا الشعار لا يخرج من فراغ. بل هو مأخوذ مباشرة من نونيس، المفكر الذي لم يكن وحيدًا في تبنّيه، إذ سبقه إليه آخرون بصيغ مختلفة، مثل قولهم: "الوظيفة فوق الشكل". وقد أراد نونيس أن يعالج بما كتبه ما سماه "الصدمة المزدوجة لليسار"، أي تلك الضربتين القاسيتين اللتين تلقاهما هذا التيار: الأولى حين تحوّل الاتحاد السوفيتي إلى دولة شمولية، والثانية حين فشلت مقاربات 1968 الأفقية التي وعدت بالحرية والعدالة ولم تأتِ بشيء.
وحتى نُدرك عمق هذه الصدمة، لا بد أن نلج إلى أعماق النفس اليسارية، حيث جراح قديمة لم تُشفَ، وغضب كامن تُرجم عبر السنوات إلى ما نسميه الآن "ثقافة الهويات التنظيمية".
فما الذي حدث؟ ببساطة، تحوّلت الخلافات الحقيقية، السياسية والفكرية، إلى معارك هوية لا مضمون فيها. أصبحنا نرى في صفوف اليسار تناحرات لا تقوم على الاختلاف في الأهداف أو القيم، بل على طريقة التنظيم والممارسة. الاستبدادي في نظر أحدهم هو من يُنظّم وقته بدقة خلال الاجتماعات. والفوضوي عند الطرف المقابل هو من يُضيع الوقت في مناقشة رموز لا تهم أحدًا.
فلو استمعت لحوار بين فريقين متضادين في هذا التيار، قد تسمعه كالتالي:
– أنا أفضل منك، لأنني أنظم جمعيات عامة.
– لا، أنا أفضل لأن عندنا فرقًا توزع المنشورات.
– أنت فاشي، لأنك تحسب وقت المتحدثين.
– وأنت فوضوي، لأنك تناقش لساعات حول استخدام النجمة أو الحرف.
وهكذا، صارت طريقة التنظيم هي السياسة ذاتها، وصارت الهوية غاية، ولم تعد وسيلة. وضاعت الأهداف، وتوارت في الخلف.
نونيس يقدّم علاجًا بسيطًا وعميقًا في الوقت نفسه: يجب أن نبدأ من الغاية، من التغيير الذي نريد إحداثه، ثم نبحث عن أفضل استراتيجية لتحقيقه، وبعد ذلك فقط نختار الشكل التنظيمي الملائم. الشكل هنا أداة، لا شعارًا ولا هوية.
فلنعد إلى شعارنا، "القوة قبل الشكل".
الشكل التنظيمي لا يُختار لذاته، بل بحسب المهمة التي ننوي القيام بها. يجب أن يكون هذا الشكل قادرًا على التعامل مع ما يفرضه الواقع من تعقيد معرفي، ومعلوماتي، ولوجستي. وهذا لا يتم بالنية وحدها، بل عبر دراسة واعية لكيفية بناء المنظمات، وتشكيل الأنظمة، وضبط العمليات، وفهم النفس البشرية في العمل الجماعي. وهي مجالات لها أسماء معروفة: تصميم المنظمات، تصميم الأنظمة، تسهيل الاجتماعات، علم النفس التنظيمي، نظرية النظم، بناء الحركات... وغيرها.
ولأني وعدتك بالبساطة، فلن أطيل في هذه المصطلحات، لكني أقدّم لك دعوة صريحة.
هل ترغب في أن تكون سياستك أكثر فاعلية؟
إذن، دع عنك مؤقتًا الكتب المطوّلة عن نزاعات لم تندمل بعد – مثل ناغورني كاراباخ – واقرأ بدلًا منها كتابًا عن الاجتماعيات، أو خذ دورة في تصميم العمليات، أو تعلّم كيف تُيسّر النقاشات بفعالية، أو حتى جرّب تطوير الأنظمة بدون أكواد.
لأني أدرس هذه التخصصات وأمارسها، ولأني لا أكتفي بذلك بل أدخل بها إلى الفضاءات السياسية والنقابية دخول المقتحم المدرك، أستطيع أن أقول لك بثقة: الحاجة إليها ماسة، بل هي كحاجة العطشان إلى الماء في يوم قائظ. وما إن تكتسب شيئًا من الخبرة، مجرد ذرة، بحيث تستطيع أن تساعد من حولك بطريقة مجدية، حتى تجد الأبواب تُفتح لك، والقلوب تتهيأ لاستقبالك.
فالضيق الذي يشعر به الناس – من الممارسات التنظيمية التي لا تصلح، سواء أكانت عمودية بيروقراطية، أم أفقية فوضوية – ليس وهمًا، بل حقيقة راسخة. والناس يشعرون بهذا الضيق، حتى أولئك الذين لا يملكون اللغة للتعبير عنه، ولا الألفاظ التي تصوغه، ولا الوعي الذي يترجمه.
وانتقالًا إلى موضوع لا يقل خطورة: يجب أن نقاوم العفوية بكل ما أوتينا من جهد، وبجميع الوسائل.
أولًا، لأن العفوية في أبسط صورها تقول إن انتشار الشكوى في المجتمع كافٍ ليؤدي – عاجلًا أم آجلًا – إلى عمل، ثم إلى تغيير. وهذه فكرة خادعة تُسكّن الضمائر لكنها لا تحرك شيئًا في الواقع.
وثانيًا، لأن العفوية في صورتها الأخطر تقول: إذا فهمنا الظاهرة السياسية، أو المشكلة، أو القضية، فذلك كافٍ لإيجاد حل. كأن الفهم وحده مفتاح النجاة. وهذه خرافة أخرى تُرضي العقل لكنها لا تُنتج أثرًا.
إن بناء المنظمات السياسية ليس شيئًا عفويًا، وليس ملحقًا بالمعرفة السياسية، بل هو تخصص قائم بذاته، لا يقوم مقامه شيء. فأن تكون خبيرًا بأزمة السكن، لا يعني أنك قادر على خوض استفتاء ناجح لمصادرة أملاك كبار مطوّري العقارات. وهذا ما رأيناه في حملة DWE الشهيرة التي افتُتحت في مقدمة هذا الحديث.
لقد انتصروا في الاستفتاء لا لأنهم كانوا على حق وحسب، بل لأنهم اتبعوا منهجية دقيقة ومدروسة في التنظيم: تجنيد متطوعين بطريقة منظمة، واجهات واضحة لكل وحدة في اتصالها مع المركز، مواد ترويجية مصممة لكل فئة عمرية وطبقة اجتماعية، هوية بصرية أصيلة يسهل التعرف عليها، تدريبات محكمة، إحاطات يومية للمتطوعين، عمل ميداني مباشر، طرق على الأبواب، وتحركات في أماكن حضرية غير متوقعة. ولأضرب لك مثالًا لا يُنسى: جمعوا توقيعي أنا في العاشرة ليلًا، على العشب أمام مسرح فولكسبونه. في مكان لم أرَ فيه من قبل أحدًا يجمع توقيعات.
وهذا النوع من الكفاءة لا يرتبط بالقيم النبيلة أو الشريرة، بل هو محايد، ويمكن أن يخدم الخير كما يمكن أن يخدم الشر. نعم، حتى المنظمات التي تريد أن تصنع عالمًا مروعًا، تملك أحيانًا أدوات تنظيمية متقنة يمكننا – بل يجب علينا – أن نتعلم منها، ثم نُطهّرها من أدران الأيديولوجيا، ونُعيد استخدامها لأهدافنا.
خذ مثلًا تنظيم الـ SS: لم يكن هرميًا صارمًا كما نظن، بل كان لا مركزيًا إلى حد بعيد، ويعتمد على استقلالية اتخاذ القرار، أقرب إلى التنظيم الفوضوي منه إلى جيش منضبط. أو انظر إلى نظام "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى": في وقت كتابة هذا النص، كان هذا المشروع يتكوّن من 110 منظمة وقّعت على "مشروع 2025"، إلى جانب مئات أخرى على الهامش، لكل منها فكرها ومبادئها ومشاريعها: من أنصار الملكية الجدد، إلى الميليشيات، إلى جماعات السحالي، إلى الإنجيليين، إلى ملوك التكنولوجيا.
ما الذي يجمع كل هؤلاء؟ هدف واحد: دعم ترشيح ترامب، وإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي، لا على أساس التقدم بل على أساس الارتداد والرجعية.
ثالثاً: لا يمكنك أن تكشف الملك في أول نقلة.
فهذا المبدأ يكرر ما سبق أن قيل: ضع هدفك في المركز، ولا تُشغل نفسك بالباقي إلا بعده. لكن المشكلة أن وضع الهدف شيء، ومعرفة طريق الوصول إليه شيء آخر، أشد صعوبة وأعظم غموضًا.
فإذا نظرنا إلى الأمر نظرة شاملة، علمية، سيبرنيتيكية كما يقول أهل الاختصاص، لن نجد مهربًا من الاعتراف بالحقيقة القاسية: لن نملك أبدًا معلومات كافية لنضع خطة سياسية تؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي نرجوها. هناك دائمًا فجوة، غموض، متغيرات خارجة عن الحسبان.
يستخدم نونيس تعبيرًا صعبًا، يسميه "النهج الغائي". وماذا يعني هذا التعبير؟ يعني أن التاريخ، وما يحدث في المجتمع، يسير وفق قوانين دقيقة، يمكن – في رأي بعضهم – أن نعرفها علميًا، فإذا عرفناها، وتمكّنا من فهمها، صرنا قادرين على تخطيط العمل السياسي، وتطبيقه في الواقع كما نُخطّط له على الورق تمامًا.
ولكن، ورغم أن نقد هذا الفهم الغائي للتاريخ قد أُشبع تحليلًا، ورغم أننا تجاوزناه – أو هكذا نظن – إلا أن كثيرًا من الفضاءات السياسية لا تزال تتصرف وكأننا في القرن التاسع عشر! يجلس أصحابه على كراسٍ رخيصة، بعضها من البلاستيك المكسور، في أقبية أندية إقليمية، ينظرون إلى التاريخ ببرود كأنهم في مقاعد المحلّلين، ثم يُعلنون ما يظنونه "الخط الذي يجب أن نسلكه"... ذلك الخط الذي يقود، في الغالب، إلى الهزيمة.
ولماذا نقع في هذا؟ لأننا نُحوّل الأيديولوجيا إلى علم، فنمزج بين ما نريده وبين ما هو موجود أمامنا، ونفقد بذلك صلتنا بالواقع.
ولا يعني هذا أن نرمي بالأيديولوجيا في البحر! فذلك لا يمكن، ولا هو أمر معقول. لكن الأيديولوجيات التي نملكها اليوم، ببساطة، لا تصلح للعالم الذي نعيشه. لا أفكاري، ولا طريقة عملي، ولا حتى هذا المقال، تنتمي لتلك الأيديولوجيات القديمة. بل إننا، من خلال هذا كلّه، نبني أيديولوجيات جديدة، أكثر نفعًا وأشد ارتباطًا بالأهداف، وأقرب إلى الناس. لا أحد يعرف شكل السياسة في عام 2050، لكني أرجو – بل أُصرّ – أن تكون مختلفة عن سياسة هذا اليوم!
رابعًا: السياسة تحتاج أن تُلعب بكل أوراقها.
فإذا كانت السياسة، كما اتفقنا، هي فن تحديد الأهداف وتحقيقها، وإذا كنا نُريد بناء استراتيجية قابلة للتطبيق، وإذا كنا نواجه عالمًا معقدًا لا يرحم، فلابد لنا من قرارات واضحة: كيف نتصرف؟ ما الطريق الذي نسلكه؟ ما الأدوات التي نستخدمها؟ ما الأساليب، وما الرسائل، وما الجماليات، وما الطقوس، وما الهويات، وما اللغات، وما التنظيمات؟ لا شيء يجب أن يُستبعد فقط لأنه "يبدو رأسماليًا" أو "يمينيًا جدًا". الغاية تبرر الوسيلة، والضعف ليس فضيلة. أن تفشل لأنك رفضت الأدوات الفعالة، فهذا ترف يمارسه من يخوض السياسة بدافع العقيدة، لا بدافع الضرورة.
نُكرر هذه العبارات في السنوات الأخيرة، نرددها بلا توقف، لكن النتائج؟ ما زالت باهتة.
القول سهل، أما الفعل فأصعب. بناء الحجج، وإطلاق النداءات، وتقديم المناشدات من أجل "الوحدة" أو "التسوية"، كل هذا لا يكفي. لا يُنتج وحدة حقيقية، ولا يُكسبك معركة.
وغالبًا ما نجد أن تحت ما يسمّى "النقاء السياسي" نفسية دفاعية، فردية وجماعية، تحاول التستر على عجزنا.
ففي وجه تحديات هائلة، تُربك العقول، وتُثقِل النفوس، والتي قد تبدو أكثر ضخامة حين نُكثر من دراستها وتحليلها، يكون الهروب أسهل من المواجهة. وهنا تبدأ النفس في بناء الحصون الوهمية لتُخفي استسلامها: ترفض المخاطرة، تبتعد عن الخطر، وتُنكر على نفسها أنها قد استسلمت، بل تُقنع نفسها والآخرين بأنها فقط "واقعية".
فتقول مثلًا: "الظروف المادية لا تساعد". أو: "الوسطيون خدعونا". أو: "هذه النقابة لا تُجدي، لأن أعضاؤها يمينيون". كل هذه العبارات ليست إلا دروعًا تحمي بها النفس كرامتها من الإذلال، تواسي نفسها بالخسارة، وتُبرّر العجز.
وقد تُشعِرنا هذه الأعذار بشيء من الراحة... لكنها تُقعِدنا. تُبقينا سالمين من الخطر، لكن عاجزين عن الفعل.
فإذا كانت هذه الديناميكية نابعة من النفس، وإذا كانت وليدة الصدمة، فإن من ينادي بالوحدة السياسية، يُشبه تمامًا من يدعو شخصًا مكتئبًا إلى نزهة في الغابة. نعم، قد تكون النزهة تسلية مؤقتة، وقد تلهي العقل لحظة، لكنها لن تُداوي جرح الاكتئاب، ولن تعالج أسبابه العميقة.
ولهذا، فالعلاج الحقيقي لهذا النوع من الدفاع النفسي لا يكون بكلمات تُقال في الهواء، بل بخطوات أخرى، أعمق وأصدق. علينا أن نعيد للناس حريتهم في الفعل، وأن نمنحهم القدرة على رؤية نتائج أعمالهم، هذا ما يسميه الأمريكيون: "التمكين". وهذا التمكين لا يجوز أن يكون تقنيًا فقط، بل ينبغي أن يبدأ من الداخل: من النفس، من القلب، من الروح.
وإذا لم تكن الظروف مهيأة لانتصارات كبرى تُحرّك الجماهير وتزلزل الأرض، فعلينا أن نرضى بانتصارات صغيرة، محددة، ملموسة. يكفي أن ينتصر العمال في إضراب بعد أشهر من النضال المرير، لتنتابهم فرحة تشبه، في وجدانهم، نشوة من استيقظ في صباح الثورة. ذلك الإحساس بالكرامة، بالإمكان، بالقدرة على التغيير، يُغني عن مئة بيان ومقال.
وهناك طريق آخر لمداواة هذا الجرح، طريق لا يُداوي الألم مباشرة، بل يُخفف من عواقب ردات فعله الأكثر عدوانية.
فلنصنع فضاءات نلتقي فيها بمن يخالفنا الرأي، لا لكي نتجادل ونتنازع، بل لنخرج من تلك المواجهة بشيء مفيد، لنا ولهم. الأمر هنا لا يتعلق بمجرد "معرفة"، بل هو تجربة حيّة، تمرين يومي. لنكفّ عن التمسك بحوار الرفاق المتشابهين، ولنجرّب نوعًا جديدًا من الدبلوماسية؛ دبلوماسية أقل طموحًا، لكنها أكثر واقعية، مع من لا يشاركوننا الرؤية ولا يتكلمون بلغتنا.
فالسياسة ليست سوى وساطة بين أضداد لا يمكن التوفيق بينها، لكنها مع ذلك تحاول دائمًا، من جديد، أن تنسج بينها خيطًا مشتركًا، صغيرًا كان أو كبيرًا.
وهذا يجب ألا يبقى مجرد مبدأ نظري، بل يتحوّل إلى تمرين روحي. بل زهد سياسي! قل كل يوم شيئًا لا تؤمن به تمامًا، ساند شخصًا لا تتفق معه، استعمل كلمة لا تحبها، وحاول أن ترى العالم من زاوية من يعاديك. وعندما تميل إلى أن تقول: "لا، ولكن..."، جرب أن تقول بدلًا منها: "نعم، و...".
عندها فقط، تبدأ في توسيع مجموعة أوراق اللعب التي بين يديك، وتزداد فرصك في الانتصار.
خامسًا: باتّي كياري، أميتشيتسا لونجا
يقول الإيطاليون هذا المثل الشعبي، ويعنون به: "الاتفاقات الواضحة، تؤدي إلى صداقات طويلة الأمد." وهو مثلٌ بسيط، لكنه يختزل قاعدة ذهبية لكل علاقة صحية ومستقرة: الوضوح. أن يكون كل شيء واضحًا، من الشروط إلى الالتزامات، من التوقعات إلى اللغة نفسها. حين يكون التواصل شفافًا، تنمو الثقة، ويستقر البناء.
وهذا ليس صحيحًا فقط في الصداقات أو العلاقات العاطفية، بل في السياسة كذلك، سواء كانت أحزابًا كبيرة أو حركات صغيرة. الثقة لا تولد من النوايا الطيبة وحدها، بل من وضوح الكلام وتحديد المسؤوليات. وهذا ما يردده لنا الأطباء النفسيون، وما يُدرَّس في دورات "التواصل اللاعنفي"، لكنه لا يُقال بما يكفي عندما ننتقل إلى أرض التنظيم السياسي.
فالضبابية في الكلام والتصرفات تُخزّن في داخلها إمكانية الصراع. وحين لا نكون واضحين، نترك لكل طرف مجالًا ليفهم الأمور بطريقته، فتظهر التفسيرات المتناقضة، ويتولد منها الخلاف.
أما التوضيح، فهو أشبه بإجراء جراحي مبكر: يحوّل حربًا محتملة في المستقبل إلى خلاف بسيط اليوم، خلاف يمكن حله، ومعالجته. وهذا التوضيح يعني أن نتوقع منذ البداية ما قد يشعر به الطرف الآخر لاحقًا من خيبة، أو قلة احترام، أو فقدان للثقة، أو خوف من صراع جديد. وعلينا أن نفتح لهذه المخاوف بابًا في نقاشاتنا المبكرة، وأن نُوضح منذ البداية: ما معنى الاتفاق؟ وماذا على كل طرف أن يفعل؟
ومن الناس من إذا تناول هذا الشأن بالجدّ الكامل، سواء أكان في ميدان العمل أم في ساحة السياسة، فإنه لا يرضى بالغموض ولا يطمئن له، بل يسعى في محوه بكل وسيلة. وقد اخترع أمثال هؤلاء عددًا لا يُحصى من الأدوات والأساليب لمحاربة هذا الغموض وتقليصه إلى أدنى حد، إذ هو بطبيعته لصيق بالتفاعل الإنساني، لا يُفارقنا. فلجأوا إلى تقنيات التيسير، وأساليب الوساطة، وتنظيم المعرفة، وصياغة الوثائق، وتصميم العمليات.
ولكن، ليس من الواجب أن نبدأ دائمًا بهذه الوسائل المعقدة والمتقدمة كي نحصل على نتائج ملموسة. فقد يكفي، في بداية الطريق، أن نتمسك ببعض المبادئ البسيطة، وهي في ظاهرها سهلة، لكن بعضها قد يتطلب تحولًا داخليًا، مؤلمًا ومتعبًا في بعض الأحيان.
وأحب أن أذكر هنا ثلاث أفكار أراها ذات نفع عظيم، وأثرها واضح في تحسين العمل الجماعي:
أولًا: تدوين وتتبع ما يتطلب سلوكيات محددة
حين نضع قواعد داخلية، أو نوزع المهام، أو نعقد اتفاقات بين مؤسسات، فعلينا أن نكتب كل شيء. فإن لم يُكتب، فلا يُعتد به. وقد صدق الرومان حين قالوا: "الكلمات تطير، أما المكتوب فيبقى". وهذا لا يعني فقط أن نحرص على التوثيق، بل أن نتحمل جميعًا مسؤولية التوضيح، وألّا نغضب إن نسي أحدهم أمرًا لم يُكتب. فالنسيان ليس خيانة، بل فرصة لممارسة الصبر والتفهّم.
ثانيًا: توحيد الإجراءات الأكثر شيوعًا بوثائق واضحة
لنأخذ مثالًا بسيطًا: إذا كان في مؤسستك طقوس معروفة في تنظيم الفعاليات، ثم أردت أن تسند مهمة التنظيم إلى عضو جديد، فلا يصح أن تتركه يتخبط وحده. يجب أن تسلمه دليلًا واضحًا يشرح له الخطوات، يحدد له من يتعاون معه، وكيف يروّج للفعالية، وما الأمور التي ينبغي مراعاتها. فإن أخطأ، فليس الذنب ذنبه، بل هو خطأ من كتب الوثيقة أو أهملها.
ثالثًا: التمييز الصريح بين المعلومات المهمة وتلك الزائدة
وهذا مما تكثر مشاكله في الجمعيات والمنظمات. كم من محضر دُوِّن تفصيلًا مملًا، يمتد على صفحات كثيرة؟ أو كم من اتفاق عُقد شفهيًا، ثم دُفن في مقطع فيديو يمتد لساعتين؟ ثم بعد شهور، يُطلب ممن لم يحضر، أو ممن نسي، أن يراجع هذا السيل من الكلمات والصور ليستخرج معلومة واحدة. هذا عبث! بل هو ضرب من دفن المعلومات عمدًا.
علينا أن نُفرّق في مساحاتنا المكتوبة والرقمية بين ما نحتاجه بعد أشهر وسنوات، وبين ما ندوّنه لمجرد التوثيق. فالمعلومة حين تغرق وسط الزحام، لا تعود معرفة، بل تصبح عائقًا أمامها.
وهذه الأخطاء ليست مجرد تفاصيل صغيرة، بل قد تكون قاتلة، خاصة في المنظمات الصغيرة، التي لا تملك إلا القليل من الوقت والجهد. إذ أن كثرة الاحتكاك تستهلك طاقتها، وتُطفئ شرارتها سريعًا. وما نراه في النهاية؟ بيان طويل بارد، لا يحمل إلا عبارات من نوع: "السياسة هي أن تتعلم كيف تخسر بطريقة أفضل". أو جمل أخرى، لا تسمن ولا تغني، مما يُقال فقط لتسلية النفس وتخفيف الخيبة.
فأما المنظمات الكبرى، التي طال بها العهد، ورسخت جذورها، وكان لها من الموارد ما يعينها، والتي نشأت في زمن كانت فيه الأوراق هي الوسيط الوحيد، والأقلام هي أداة الحكم والإدارة، فإنها – في أغلب الأحوال – تستهلك طاقتها كلها في صراعات داخلية واحتكاكات تنظيمية لا تنتهي. والنقابات والأحزاب هي أوضح الأمثلة على ذلك. فهي كثيرًا ما تُمثّل أسوأ ما يمكن أن تصل إليه الفوضى الإدارية: إذ تُحتكر الوظائف الاستراتيجية في المركز، فيصيب العمل الميداني جمودٌ قاتل، وتضطر الفروع المحلية إلى إعادة اختراع كل خطوة، وكأنها تبدأ من الصفر.
وليس من العجب – والحال هذه – أن كثيرًا من الشباب، متى خطوا أولى خطواتهم في العمل السياسي، سرعان ما يغادرون هذه البُنى المهترئة، باحثين عن فضاءات أرحب، وحركات أكثر مرونة، ومساحات تسمح بالمناورة: كمراكز البحوث، والمجموعات المستقلة، والمنظمات المدنية، ومدارس الحركات الاجتماعية، وجماعات الضغط. فالناس اليوم لم يعودوا يحتملون أن يُسجنوا داخل منظمات اختلّ توازنها.
ولكن، مهلاً! لا تُسرف في الحكم، ولا تجعل من نفسك خصمًا مناوئًا لكل ما هو قديم. فكون هذه الهياكل متعبة، وبطيئة، وصعبة الإصلاح، لا يعني أنها العدو الذي يجب هدمه، ولا أنها الشرّ المطلق الذي لا يُحتمل. فإذا نظرنا إليها من هذا المنظور، فإننا لا نفعل شيئًا سوى إعادة إنتاج صدماتنا السابقة، في هيئة جديدة: فتصبح الأحزاب كلها شرًا، والجمعيات كلها خيرًا. وتُصبغ النقابات بالسواد، والمجموعات الصغيرة بالنقاء. وهذا ليس من الحكمة في شيء.
بل الحق أن إدراك حدود تلك البُنى القديمة ينبغي أن يعلّمنا كيف نصوغ استراتيجياتنا، لا أن نغرق في أحكام أخلاقية تُغلق الأبواب. علينا أن نتفاعل مع هذه المؤسسات، باعتبارها جزءًا من النظام الذي نعيش فيه، لا أن نهرب منها أو نُقصيها. فعلينا أن ننتبه لجمودها، وصراعاتها، ونتعلّم منها ما لا ينبغي أن نكرره، ونفكّر في أشكال جديدة من التنظيم والعمل.
وليس من سبيل إلى إصلاح هذه الكيانات الضخمة إلا طريقٌ طويل، شاق، معقد. ولكن، من المؤسف أن لا أحد يبدو مستعدًا للقيام بهذا العمل. ولعله لهذا السبب، ستنقرض كما انقرضت الديناصورات!
ومن النافذة التي أطللتُ منها على واقع النقابات الأمريكية الحديثة، بدا لي الفارق شاسعًا بينها وبين نظيراتها الإيطالية. وليس ذلك لأن الأمريكيين أكثر ذكاءً أو يملكون من المال أكثر، بل لأنهم يعاملون التنظيم الإداري كقيمة قائمة بذاتها، وكاختصاص ينبغي أن يتقنه النقابي منذ أول الطريق.
أما في إيطاليا، فإن الأهمية القصوى تُمنح لقدرة المرء على الجدل، وعلى خطب ودّ العمال بالكلمات المؤثرة. في حين أن النقابات الأمريكية تركّز على المنهج، على الحساب، على التكرار، على قابلية التوسّع، وعلى الأتمتة، بحيث يتمكن عدد قليل من النقابيين المتفرغين من تنظيم مئات العمال، وجمع آلاف الأصوات، بوسائل منهجية مدروسة. بل قبل أن يُدرَّب الناشط على أبسط أشكال المحادثة الفردية، يتم تلقينه طريقة تُدعى Bullseye، وهي طريقة دقيقة في الحشد والإقناع.
وهذا – بطول الوقت – يصنع فرقًا لا يُستهان به.
سادسًا: السياسة حين يدخل فيها "الموضوع"
هذا الشعار قد يبدو بسيطًا، وربما أقلّ جاذبية من سواه، لكنه – رغم بساطته – يُعبّر عن مسألة مركزية في السياسة الشاملة: وهي أننا، نحن الذين نمارس السياسة، لا نعيش في عالم خارجي، بعيد عن النظام الذي نريد تغييره. لا وجود لهذا "الخارج" أصلاً! فنحن جزء من كل ما نسعى إلى فهمه، وتغييره، وتفكيكه.
نحن لا نقف على الرصيف، بل نمشي في قلب الطريق. لا نُشاهد من بعيد، بل نُعاني ونُشارك. وإن زعمتَ أنك تملك موقعًا محايدًا، فدلّني عليه. أين هو؟ من هذا الذي تحرر من تأثير العالم؟ من هذا الذي لا تجرفه التيارات الاجتماعية، ولا تمسه ديناميكيات الزمان والمكان؟
إننا كالسفن في البحر، تدفعها الرياح، وتحاول أن تقرأ الخرائط. نعم، الخرائط تساعدنا، لكنها ليست البحر. وليست اليابسة. إنها فقط مجاز يقرب الفهم.
وهذا المنظور – أعني الشعور بأننا جزء من المنظومة – قادر على زعزعة كثير من الأيديولوجيات، والممارسات، والمواقف النفسية التي توهم أصحابها أنهم أحرار ومستقلون، بينما هم، في حقيقتهم، غارقون في دفاع مستتر عن النظام نفسه الذي يُدينونه. وغالبًا ما يختبئ هذا التناقض وراء هياكل سلطة، وديناميات سياسية، لا يُراد لها أن تُرى.
لعلّ القارئ يظن حين يسمع لفظ "الاستقلالية" أنها تلك القدرة على أن نضع قوانيننا بأيدينا، وأن نعيش بمعزل عن غيرنا. لكن الحقيقة التي لا مهرب منها أن الاستقلال هنا لا يُراد به معناه الحرفي، بل شيء أعمق وأعسر منالا. الاستقلالية تعني أن نتحرر من منطق النظام الاجتماعي الذي يحيط بنا، والذي يزرع فينا منذ نعومة أظفارنا ما نتصوّره حرية واختيارًا. وهي كذلك تعني أن نتخلى، ولو إلى حين، عن تلك الرغبة الخفية في تحصين أنفسنا من تأثير بيئة صنعت ماضينا، وتهيمن على قدرتنا على الفعل في حاضرنا، وتمدّ بظلالها على ما نُقدم عليه في مستقبلنا.
وقد يُخيّل إلى البعض أن في المجتمع ثقافتين: واحدة مهيمنة، وأخرى مضادة تحاول الانفكاك. ولكن الأمرعلى خلاف ما يُظن. فما من ثقافة مضادة على الحقيقة، بل هو نظام ثقافي واحد، متشابك الخيوط، متباين الحضور والسطوة بتفاوت الزمان والمكان. ففي هذا النظام فاعلون يملكون كثيرًا من الموارد، يهيمنون ويتسيّدون، وفاعلون آخرون لا يملكون إلا القليل، فيكتفون بما تسمح لهم به هذه المنظومة من زوايا ضيقة ومساحات محدودة.
ولعل البعض يتوهّم أن هناك أماكن تستطيع فيها أن تفعل ما تشاء، حيث لا رقيب ولا حسيب، ولكن هيهات! فهذه المناطق التي يُقال إنها مستقلة، ما هي إلا مساحات مؤقتة، قد تتسع حتى تصل الشرطة، أو تضيق حتى يحين موعد دوامك. وكل مشروع سياسي، مهما بدا حراً أو متفلّتًا من القيود — سواء أكان مهرجانًا صاخبًا أو حفلًا راقصًا أو حركة سياسية — ما يلبث أن يصطدم بالنظام القائم، فيعود من حيث بدأ.
وما من شك في أن مثل هذه التجارب تنفع الناس بعض النفع؛ فهي تُحرر خيالهم، ولو جزئيًّا. غير أن فائدتها لا تتجاوز هذا الحد. تمامًا كما تُزرع الشتلة في أصيص صغير في أيام البرد، ريثما تتحسن الظروف، ثم تُنقل إلى الأرض. فإن كانت الأرض غير صالحة، أو الجو قاسيًا، فإن الشتلة ستموت حتمًا. وهذا الأصيص، وإن بدا ضروريًا، إلا أنه لا يغني عن الأرض شيئًا. كذلك إلهام الآخرين: إن لم يكن بإمكانهم أن يحذوا حذوك، وأن يسيروا على خطاك، فلن ينفعهم الإلهام. فما يسمى "سياسة تمهيدية" لا يُغير ترتيب الأحجار على رقعة الشطرنج، وإنما — في أحسن الأحوال — يلهمك بحركتك التالية.
وقد راجت في هذه الأيام دعوة إلى الهروب من المجتمع، وكأنّ الفكاك من قبضة العالم ممكن. والحقيقة أن حتى أكثر المجتمعات عزلةً، وأشدّها استقلالًا، لا تملك إلا أن تتعامل مع النظام الصناعي الذي يحكم هذا العصر. فبقاء هذه المجتمعات مهدّد بما يشهده العالم من تغيّرات مناخية، ومن تحلل في البيئة، ومن جسيمات بلاستيكية لا تكاد تترك بقعة من هذا الكوكب إلا غطّتها.
وحين ننتقل إلى مستوى أكثر تجريدًا، نجد مفارقة محزنة. إذ ترى هؤلاء الذين قرروا أن يعيشوا في مزرعة معزولة بين التلال، يتجادلون في المساء حول ما إن كان شراء ورق التواليت يعني الوقوع في قبضة النظام الرأسمالي. ولو علموا أن هذا القرار نفسه لم يكن لينبع إلا من ديناميكيات هذا النظام ذاته! ففي سلسلة أفلام "الماتريكس"، لم تكن مدينة "زيون" الثائرة إلا جزءًا من المحاكاة التي أقامتها الآلات لاحتجاز البشر. وهكذا، ليس في الأمر مخرج.
كان ولا يزال في الناس من يظنّ — سواء أكانوا من الثائرين المتحمّسين أو من الإصلاحيين الحالمين — أن بلوغ السلطة هو الغاية الكبرى، والنهاية التي عندها يستقر الأمر، وتبدأ حياة جديدة. غير أن الواقع، لا يُجاري هذا الظن، ولا يهادن أصحابه. ففي صبيحة اليوم الذي يلي الثورة، تجد العالم كما كان عشية الأمس. فليس بين عشية وضحاها تنقلب الدنيا، ولا بين انتخاب وجولة عسكرية يُرسم لوحٌ أبيض، أو يُمحى من الوجود حاضرٌ مكتمل لنقيم على أنقاضه عالماً جديدًا، خاليًا من القيود، طاهرًا من شوائب الماضي، وكأنما هو صفحة بيضاء لم يُخطّ فيها شيء من قبل. هذا وهم لطالما خدع النفوس المتعجلة.
ثم إن بعض من يتصدّى لتحليل المجتمع وقراءة السياسة، يتوهّم أنه يقف خارج هذا العالم الاجتماعي الذي يفككه. يتصوّر أنه عالمٌ محايد، موضوعي، لا يتأثر بما يرصده أو بما يدور حوله. والحقيقة أن لا فرد ولا جماعة يمكنها الزعم بأنها خارج هذه الظواهر، فكلنا في قلبها شئنا أم أبينا. والمشكلة ليست أن تكون بداخلها، فهذا أمر حتمي، بل أن تعي موقعك هذا، أو أن تخادع نفسك فتوهمها أنك قد خرجت. ومن جرب الحياتين علم أن الوعي بوجودك داخل المنظومة يُثمر فهمًا أعمق، وفعلاً أنضج، وممارسة سياسية أقدر على بلوغ الغايات. وأدعوك، أيها القارئ الكريم، أن تحكم بنفسك أيّ الخيارين أصلح وأبقى.
سابعاً. عدونا هو نتفليكس
ثم نبلغ مبدًأ لا يقل شأنًا عمّا مضى، وهو أننا حين نخاطب الناس سياسيًا، لا نخاطب عقولاً مجرّدة من اللحم والعظم. إنما نخاطب بشراً لهم أجساد وأمزجة وعقول مرهقة وهورمونات مضطربة وأعصاب متوترة. إنهم — ببساطة — كائنات حية تريد أن تشعر بالارتياح. وها هنا يتبدى لنا سرُّ نجاح نتفليكس: إذ لا تعرض هذه المنصة محتوى لأن العقول تحتاج إلى غذاء معرفي، بل لأنها تعرف أن الناس يسعون إلى التشتّت، وأنهم يملكون طاقة محدودة لاختيار ما يشاهدون أو البحث عن الجيد من الأفلام والمسلسلات. ولأنها تُقدّم مادة بلا حدود، صار الإقبال عليها إدمانًا، يستهلك الوقت، ويسلب الساعات، ثم يحوّلها إلى أرباح تُكدّس وأرقام تُسجّل.
إنك تعود إلى منزلك، فتفتح نتفليكس، ولا تنطفئ الشاشة إلا عندما تستسلم للنوم، والحاسوب فوق صدرك.
أما أنا، وإن كنت لا أتابع الأفلام ولا المسلسلات، فإن لي مع ألعاب الفيديو قصة لا تختلف كثيرًا. علاقة بدأت منذ أعوام، وأخذت من وقتي ما شاء لها أن تأخذ، حتى قررتُ أن أضع لها حدودًا، فاستعدت وقتي شيئًا فشيئًا، وملأته بما يحمل معنى، لا بما يسرق الساعات خفيةً. ولقد كنت من القلائل الذين أنقذهم الحظ من هذا الطوفان، وأعانهم على النجاة.
على أن هذه المشكلة لا تقتصر على نتفليكس أو ألعاب الفيديو. فالآخرون يصارعونها مع التلفاز القديم، أو مع تيك توك الجديد. والنتيجة واحدة: انشغال زائد، وتشتت مستمر.
ولعلّ أخطر ما في الأمر أن كثيرًا من الممارسات السياسية العتيقة لا تصلح في مواجهة هذا التحوّل الذي مسّ وقت الناس الخاص، ولا تقوى على مقاومة اقتصاد الاهتمام الذي يخطف الأنظار، ولا تعي أن هذا الانسحاب السياسي، ليس لأن الناس فقدوا قيمهم أو عقائدهم، بل لأن طاقتهم نفسها لم تعد تسمح لهم بالاشتباك، ولا بالوقوف في الساحات. المسألة، إذن، ليست مسألة قناعة، بل مسألة قدرة.
ما زالت كثير من المساحات السياسية، في أيامنا هذه، تستند إلى ممارسات قد وُلدت ونمت في عصور كان فيها الاهتمام متاحًا، والوقت الشخصي غير مرهون لشركات عابرة للحدود، تستنزف ساعات الناس وتبتلع أوقاتهم. في تلك الأيام، كان أقصى ما يهدد هذا الوقت تعب يوم عملٍ ينقضي عند الغروب. أما الآن، فهذه الممارسات لم تعد تنجح إلا في جذب فئة قليلة من الناس، أولئك الذين يتوافر لديهم وقتٌ شخصي معقول. وهذا الوقت، في الغالب، يكون قد امتلأ بأنشطة سياسية، أو بمشاركات اجتماعية متنوعة، تحكمها ظروف فردية، أو التزام مقصود بإدارة الوقت.
وقد صار هذا الأمر امتيازًا لفئة صغيرة، في تضاؤل مستمر، وأكثرهم من هم دون سن الخمسين.
فلنعد إلى ما أعلناه شعارًا: العدو هو نتفليكس. نعم، لأن السياسة وبث الأفلام يتنافسان على المورد نفسه: وقت الناس واهتمامهم. وللأسف — حتى هذه الساعة — فإن نتفليكس هو الغالب.
فما السبيل إذن؟ كيف تنافس مثل هذا العدو؟ الجواب واضح لمن عقل: يجب أن تكون المشاركة في مشروعاتك السياسية أكثر متعة، وأكثر إثارة للاهتمام، وأكثر راحة وجاذبية وتشويقًا من مشاهدة مسلسل على الشاشة. إن اكتفيت بنداء الواجب وحده، وجعلت المشاركة تضحية شاقة، فلن تجني سوى منظمة من الشهداء الذين يتعبون ويضحكون، حتى وهم ينهكون. قد يكون هذا حسنًا لو أردت تأسيس فرقة استشهادية، أما إن كنت تعد حملة استفتاء، تطلب فيها عون عشرات الآلاف من الناس، فذلك طريق غير صالح.
ينبغي أن تجعل من العمل السياسي مسارًا يخرج منه الناس مجددين لا منهكين. إن شئت لمنظمتك أن تنمو، وتعبّئ الصفوف، وتجمع عددًا كبيرًا من الأفراد على نظام واضح، فهذا هو السبيل. أما غير ذلك فليس إلا ضربًا من العبث، لا يدوم ولا يُبنى عليه.
على أن هذا لا يعني أن نحيل السياسة إلى مسرح للترفيه، أو نكتفي بصناعة مساحات للدعم المتبادل. فهذه أمور نافعة في محيط السياسة، لكنها وحدها لا تصنع تغييرًا.
ثم إن العبرة ليست بما تفعل، وإنما بكيف تفعله. الاجتماع السياسي، أو حلقة النقاش، أو تنظيف ساحة مهملة، يمكن أن يتحول — إن أحسن ترتيبه — إلى لحظة ممتعة، تدفع الناس إلى العودة من تلقاء أنفسهم، لا بتوبيخ الضمير أو فرض الانضباط.
ثمة أشياء صغيرة، لكنها ذات أثر كبير. أبدأ — مثلًا — بإحضار الطعام. فكرة أن يجتمع الناس ولا يأكلون معًا فكرة حمقاء يجب أن تنتهي. لقد نسينا ما هو بديهي. شركات التكنولوجيا احتكرت سطوتها الثقافية بتوفير فواكه مجانية وبيتزا دافئة في مكاتبها واجتماعاتها. ونحن بشر — بل قرود فقدت شعرها كما يقول بعضهم — من يطعمنا يصبح صديقًا لنا على الفور.
لكن الطعام يجب أن يكون جيدًا. ليس شرطًا أن يكون وجبة فاخرة من مطعم فاخر، ولكن لا ينبغي أن نقدّم معكرونة مطهوة أكثر من اللازم، مع صلصة طماطم وفاصوليا لا طعم لها، فإنها تضر أكثر مما تنفع.
عنصر آخر لا يقل أهمية هو إدارة المشاعر في فضاءات العمل الجماعي. كثيرًا ما نتهرب من هذا الأمر خوفًا من فرض السيطرة، فنترك المجال للسمّ أن ينتشر، وتطفو على السطح أسوأ الشخصيات. هؤلاء يستمرون، بينما يهرب أصحاب الحساسية الزائدة، وأصحاب المعايير الصحية الأفضل. أمعن النظر في وجوه المشاركين في فعالياتك، في الاجتماعات والنقاشات. إن رأيت عليهم القلق أو التوتر أو الضيق، كن شجاعًا بما يكفي لتسأل نفسك: ما السبب؟ ماذا ينبغي أن يتغير؟
ثم لنتكلم عن الاهتمام: لا تثقل كاهل الناس بمعلومات معقّدة، وأنشطة تستنزف قدراتهم. جلسات تدوم أكثر من ستين دقيقة بلا استراحة غير محتملة. نصوص طويلة، ركيكة العبارة، محاضر فوضوية، تعليمات غائبة أو غامضة… كل هذه أمثلة على ما يهدر العقول ويبدّد الطاقات. كل شخص منا مسؤول عن تخفيف الحمل على غيره.
فالوضوح ليس مجرد ترتيب، بل هو فعل عناية ورعاية.
في الختام، تعلّم أن تحترم وقت الناس واهتمامهم، مثلما تحترم وقتك واهتمامك. ابدأ الأنشطة في موعدها، وأنهِها في وقتها. ضع نفسك في مكان من تدعوه للحضور، لتدرك حجم ما تطلبه حين تسأله سؤالًا، أو تعرض عليه فكرة، أو تدعوه لاجتماع.
مترجم من networkcultures بقلم Simone Robutti مشارك في النقابات التكنولوجية ، والمساءلة الخوارزمية ، وعلم الإنترنت المشترك ، والتصميم التنظيمي الديمقراطي. يعمل كمستشار/مدرب في تصميم التنظيم وتصميم العملية.
إذا أردت أن تُدّعم المحتوى الثقافي المقّدم لك بثمن كوب قهوة فهذا يسرنا كثيراً، فقط اضغط على الزر التالي